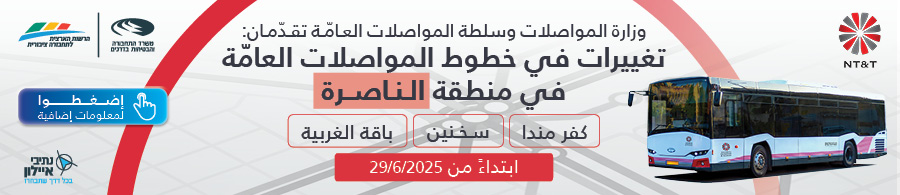رواية بين جنّتين للكاتب سرمد التايه في اليوم السابع
ديمة جمعة السمان
تاريخ النشر: 11/07/25 | 12:00
ناقشت ندوة اليوم السّابع الثقافية المقدسية الأسبوعية رواية “بين جنّتين” للكاتب الفلسطيني سرمد التّايه.
صدرت الرواية عن دار الرعاة للدراسات والنشر.. ودار جسور للنشر والتوزيع.. وتقع في 368 صفحة من القطع المتوسط.. وصمم غلافها الاختان مرام وبيان التايه وحررها لغويا أ. مفلح الاسعد.
رحّبت مديرة النّدوة ديمة جمعة السّمان بالكاتب وبالحضور، وقالت:
في روايته “بين جنتين”، يقدّم سرمد التّايه نصًا روائيًا يفيض بالتأمل، تتشابك فيه الأسئلة الوجوديّة مع الهواجس الوطنية، ويبدو فيه الكاتب وكأنه يحاور ذاته والقارئ في آنٍ معًا.
الرواية لا تسرد حكاية تقليدية بقدر ما تغزل طبقات من التجربة والذاكرة والبحث عن معنى في عالم تتكسر فيه الثنائيات: الجنّة والنّار، الوطن والمنفى، الحياة والغياب.
اللغة في الرواية تحمل حسًّا داخليًا عميقًا، ليست منمّقة ولا مسطّحة، بل من النوع الذي لا يصرخ ولا يهمس، إنما يترك أثره بهدوء. هناك عناية بالكلمة، ولكن دون تكلف. الكاتب يراهن على الصدق أكثر مما يراهن على الدهشة، وهذا ما يجعل النص قريبًا من القلب، دون أن يكون مباشرًا أو مفرطًا في الرمزية.
التّايه يكتب بلغة تعرف متى تصمت، ومتى تقول الكثير بالقليل. ما يميز العمل فعلًا هو أنه لا يقدّم إجابات بقدر ما يثير القلق الجميل: هل الجنة مكان؟ أم حالة ذهنية؟ أم لحظة نادرة في زمن مكسور؟ تتسلل هذه الأسئلة عبر السطور، مضمّنة في تفاصيل الشخصيات، وفي شتات الروح التي تبحث عن نقطة توازن بين عالمين. وبين الجنتين، يقف الإنسان الفلسطيني كائنًا معلّقًا، محمّلًا بأثقال التاريخ، وبفتات من حلم شخصي لا يقل تعقيدًا.
الغلاف لا يقلّ تعبيرًا عن مضمون الرواية، إذ اختار المصمم لوحة أقرب إلى الحلم، بألوان متداخلة بين الأزرق والرمادي، ويبدو كأن هناك بوابة في الأفق، بابًا مفتوحًا على شيء غير معلوم. ليس غلافًا صاخبًا أو مباشرًا، بل يوحي بالتردد، بالعبور الذي لا يكتمل، وكأنه صورة صامتة لمحتوى يعجّ بالأسئلة والقلق. “
بين جنتين” ليست رواية سريعة أو سهلة، بل نص يتطلب قارئًا مستعدًا لأن يتأمل أكثر مما يتسلّى، وأن يعيد قراءة بعض المقاطع لا لفهمها بل ليرى نفسه فيها.
وربما هذه هي الجنة التي يقترحها التايه علينا: أن نجد ظلّنا، أو نواجهه، في مرآة الكلمات.
وقالت د. روز اليوسف شعبان:
فلسطين والعراق جنّتان متحابّتان، تحلّق فيهما الآمال والأحلام، تستمدّ فلسطين من العراق الدعم الكبير، خاصّة في فترة الرئيس السابق صدّام حسين، فينعم كلّ فلسطينيّ يزور العراق، بالأمن والمحبّة والتشجيع.
يغادر بطل الرواية موسى جنّته فلسطين قاصدًا العراق طلبًا للعلم في جامعة بغداد العريقة، فيتبناه حال وصوله الضابط أبو كاظم الذي فقد ابنه في حرب العراق، فيدخله الجامعة قسم الهندسة رغم أنّ التسجيل كان قد انتهى، ويوفّر له غرفة للسكن في بيت صديقه أبي همّام.
يكافح موسى ويجتهد من أجل حصوله على المرتبة الأولى في دفعته، ويحظى باحترام الأساتذة والطلبة، ليس فقط بسبب اجتهاده، وإنّما لحسن أخلاقه، فكان بنظرهم خير سفير لوطنه وشعبه.
في الجامعة وتحديدًا في قسم الهندسة يتعرّف موسى على الفتاة الجميلة نوّار وهي فتاة ذكيّة مجتهدة تصرّ على تحقيق أهدافها وأحلامها، يدعمها في ذلك والدها الطبيب جاسم ووالدتها المعلمة، ورغم معارضة أخيها فاضل في تعلّم أخته لموضوع الهندسة، ورغبته في أن تتعلّم الصيدلة لتساعده في العمل، إلّا أنّه يرضخ لرغبة أخته بعد أن يقنعه والداه بضرورة إتاحة المجال لنوّار في تحقيق حلمها ورغبتها في تعلّم الهندسة كما حقّق هو حلمه بتعلّمه لموضوع الصيدلة.
ورغم التنافس الشديد بين نوّار وموسى، إلّا أنّهما أحبّا بعضهما البعض، خاصّة بعد أن اختارهما الأستاذ ليعملا معًا في مشروع هندسيّ، فيحصلان على درجة امتياز.
يتزوّج الحبيبان، ويعيشان في بغداد، خاصّة بعد أن تلقّيا تعيينًا بالتعليم في جامعة بغداد، نتيجة تميّزهما. ينجبان التوأم عليّ وعمر ثم الابنة سوسن.
لم ينس موسى أسرته فكان يأخذ أولاده كلّ صيف لزيارة فلسطين وقضاء أشهر العطلة عند أهله. لكنّ زوجته نوّار لم يسمح لها بالدخول إلى فلسطين وفق قرارات وأنظمة الحكومة الإسرائيليّة، التي تحظر دخول الغرباء من دول معادية لإسرائيل.
أثناء حرب أمريكا على العراق، في آذار 2003، يسقط نظام صدّام حسين ويعدم عام 2006، وتنهار الدولة، ويقتتل أبناء الوطن والواحد بعد أن تُزرع الفتنة والطائفيّة بينهم، فينصح الدكتور جاسم صهره موسى بالهرب إلى فلسطين، خوفًا من اغتيال الشيعة له، خاصّة أنّه سنيّ، ومتزوّج من شيعيّة ويعيش في حيّ يقطنه شيعة.
عند دخول موسى الحدود الإسرائيليّة يعتقل بتهمة تعاونه من نظام معادٍ، ويسجن إداريّا ستّة شهور، وفي يوم الإفراج عنه تقرّر السلطات تمديد اعتقاله ستّة شهور أخرى، وهكذا لخمس مرّات حتّى يقرّر الإضراب عن الطعام، وينقل إلى المستشفى، فتقرّر السلطات الإفراج عنه. وعندما يحرّر يبقى في بيت أهله ولا يتمكّن من رؤية زوجته وأولاده.
أمّا نوّار فتعيش ظروفا قاسية دون زوجها، ويذبح ابنها عمر بأيدي بعض الشيعة المتطرّفين، حين كان يلعب في ساحة البيت مع أخيه عليّ، لمجرّد أنّ اسمه عمر، نسبة إلى عمر بن الخطّاب الذي يكرهه الشيعة.
هكذا تنقلب الحياة في الجنّتين إلى جحيم لا يطاق. وتنتهي الرواية بمقتل موسى في باحات الأقصى برصاص جنود الاحتلال، حين دخلها سرًّا ليصلّي ويستدعي ربّه ليلتمّ شمل عائلته مرّة أخرى.
ثيمات بارزة في الرواية:
1.صمود الشعب الفلسطينيّ وتحدّيه، ظهر ذلك من خلال شخصيّة موسى الشاب الخلوق الذي ناضل من أجل تحقيق حلمه بالتعلّم في جامعة بغداد العريقة.
2. الفقر والذلّ الذي يعاني منهما الشعب الفلسطينيّ، ونضاله من أجل لقمة العيش واضطراره إلى العمل داخل إسرائيل وتعرّضه للحواجز وسياسة التعذيب والإذلال. إضافة إلى السجن الإداريّ دون محاكمة وتعذيب الأسرى والمساجين وتمديد فترات اعتقالهم دون محاكمة قانونيّة ودون إثبات التهم عليهم.
3. وقوف الشعب العراقي وحكومته في فترة الرئيس صدّام حسين، في النضال مع قضيّة الشعب الفلسطينيّ ودعمه من أجل نيل حرّيته واستقلاله.
4. تمثّل أسرة الدكتور جاسم، نموذجا للأسرة المتحابّة التي تعالج الخلافات بالحوار والتفاهم، ويتمتع أفرادها بحريّة اتخاذ القرارات. ربّى الوالدان ولديهما نوّار وفاضل، على الأخلاق الكريمة واحترام الإنسان لإنسانيّته بغض النظر عن ديانته وانتمائه. وهي نموذج للأسرة الناجحة تربويّا وتعليميّا ومهنيّا.
5. تدمير العراق من قبل أمريكا والدول المتعاونة معها، وتقويض حضارة دولة امتدّت آلاف السنين.
6. زرع الفتنة وبذور الطائفيّة في العراق التي ما زالت حتّى اليوم تحصد أرواح الأبرياء، وتقلب جنّة العراق إلى جحيم.
كتبت الرواية بأسلوب شائق وبلغة جميلة تخلّلتها حوارات باللغة العراقيّة المحكيّة واللغة الفلسطينيّة المحكيّة، ممّا أكسبها واقعيّة، إضافة إلى الحوارات الداخليّة.
تميّز السرد بالسارد العليم الذي يمسك بخيوط الرواية، ويحرّك الشخصيّات والأحداث وفق وما يراه مناسبًا لحبكته القصصيّة.
أمّا زمن الرواية فيمتدّ من أواخر عهد صدّام حسين سنوات الألفين وحتّى كتابة الرواية 2018.
جاءت النهاية صادمة باستشهاد البطل موسى، حبّذا لو أبقى الكاتب بطل روايته موسى حيًّا ذلك أنّه يمثّل الشعب الفلسطينيّ، وهذا الشعب حيّ لا يموت.
وقال عبدالله دعيس:
نعم … هناك مَن لا يزال قلبه ينبض بالعروبة ويرى بلاد العرب جنّات يرتع فيها كلّ عربيّ دون وجل أو خوف، رغم أنّها تحوّلت إلى جحيم يحرق حتّى من أخلص في حبّها. وإن كان الواقع قاتما، وإن أصبحت البلاد العربيّة متفرّقة متشرذمة خاضعة ذليلة، تتفانى في خدمة المستعمر وتتنكّر لأبنائها، تحتضن من غمد سيفه في خاصرتها وتقلب ظهر المجن لمن جاء ليرفدها بعلمه وماله ودمه! وإن استطاع الأعداء أن يضعوا الحكّام تحت جناحهم، وأن يحوّلوا المواطن العربيّ إلى عبد يجري من أجل قوت يومه، وإن مسخت عقول بعضهم فأصبح يؤمن بالوطنيّات الضيّقة والخطوط المستقيمة أو المتعرّجة التي أبدعها سايس و بيكو؛ فلا يجوز للكاتب والمثقّف إلّا أن يعزّز إيمانه بوحدة هذه الأمّة، ولا ينساق إلى السّكّة التي رسمها الأعداء، فيصبح ضيّق الأفق يعزّز الاختلاف والفرقة. وهذا ما يفعله الكاتب سرمد فوزي التّايه في هذه الرّواية، التي يخلق فيها جنتين على الأرض هما العراق وفلسطين، فيبدوان كطرفين في جسد واحد، يفرحان معا ويتألّمان معا، ويتحد مصيرهما، حتّى في المعاناة والرّزوح تحت وطأة الاحتلال وبشاعة المحتلّين الغرباء.
يجسّد الكاتب الوحدة بين البلدين، عن طريق شخصيّة موسى، الطالب الفلسطيني، الذي يختار أن يدرس في العراق، فتُحسن العراق استقباله ويصبح جزءا منها كأحد أبنائها، ويكون عشقه فيها، ويبني أسرته فيها. يتنقّل موسى بين العراق وفلسطين، ومن خلال رحلاته يصف الكاتب حجم ما يواجهه الإنسان العربيّ في عبور الحدود المصطنعة، وما يعانيه الفلسطينيّون في ظل الاحتلال. ثمّ تدور رحى الزّمان فتقع العراق أيضا تحت الحصار ثمّ الاحتلال الأمريكي، فيصطلي موسى وعائلته بنارها، فيصبح محطّما بين نارين تأكلا جانبيه. لكنّ الكاتب يصرّ على وصفهما بالجنّتين وإن التهمتهما نيران الأعداء الذين أذكوا روح الفتنة والطّائفيّة والاقتتال بين أبناء الأمّة الواحدة. فإن احترقت الجنّتان، فلا تزال تربتهما خصبة فيها بذور الأمّة التي لن تنالها النيران، والتي ستعود للحياة وتنمو لتكون جنّة وارفة الظّلال.
يعتمد الكاتب على السّرد المباشر لحكاية موسى، الطّالب الفلسطينيّ الذي يتوجه للدراسة في العراق، مثله مثل كثير من الطلّاب، وحكايته تتشابه مع حكاياتهم، فالأحداث متوقّعة رتيبة، لا تخرج عن المألوف، فموسى يتفوّق في دراسته، ويقع في حبّ فتاة عراقيّة ثمّ يتزوّجها. هذا السرد وبهذه الطريقة العفويّة أفقد الرّواية روح التّشويق والتّرقب التي يحتاجها المتلقي.
يستخدم الكاتب اللهجات العاميّة في الحوار، ربما ليظهر الفارق بين اللهجة العراقيّة واللهجة الفلسطينيّة، ولتصبح الرّواية أقرب إلى الواقع. استخدام اللغة المحكيّة يجعل فهم الرّواية للقرّاء من خارج البلدين صعبة. لا أعلم مدى دقّة كتابة الكلمات باللهجة العراقيّة، لكن الحوار الذي من المفترض أن يكون بلهجة إحدى القرى في منطقة رام الله أو نابلس، ليس دقيقا، فمثلا يستخدم الكاتب مرات عديدة كلمة “ضلّ” بمعنى “ظلّ”، علما أنّ القرويين يلفظون حرف الظا ولا يبدّلونه بالضاد، وكذلك يستخدم كلمة “منيح” بدل “مليح” كما يلفظها أهالي القرى.
يتدخّل الكاتب بتقرير بعض المواقف السّياسيّة، ولا يجعل القارئ يصل إلى الفكرة التي يريدها الكاتب عن طريق الإقناع بما يدور من أحداث وما تؤول إليه الشّخصيّات. فمثلا، تجربة موسى بالدّراسة في العراق، وتمكّنه من التّسجيل في الجامعة فقط عن طريق معرفته بأحد الضّباط، وحريته في الدّراسة والنّجاح والمنافسة، وعدم احتدام الخلاف والاقتتال بين الطّوائف المختلفة في ذاك الوقت، واحتضان موسى رغم اختلافه عنهم باللهجة والطّائفة، ثمّ ما آل إليه الوضع في ظلّ الاحتلال الأمريكي، تكفي لتمكّن القارئ من بناء صورة للوضع في العراق في تلك الحقبة دون تدخّل من الكاتب. لكنّ الكاتب يصرّ أن يذكر وبشكل مباشر، وأكثر من مرّة، حكم الرئيس العراقي صدّام حسين، ويعزو إليه تلك الإيجابيّات ولسقوطه كلّ السلبيّات. هذا الأسلوب غير مقنع، ويؤدّي إلى نتيجة عكس ما أراده الكاتب، فلن تكون الدّكتاتوريّة والتّسلّط يوما سببا للرخاء والوفاق، وإنّما هما غطاء لقدر تضطرم داخله نيران الفتنة، ما يتزحزح هذا الغطاء حتّى تنفجر القدر بما فيها. كان الأجدر بالكاتب أن يسرد الأحداث كما هي وسيصل القارئ إلى النّتيجة التي يريدها هو، أمّا عندما يحاول الكاتب أن يلقّن المتلقي فكرة معيّنة، فلا ينجح إلّا في عزوف القارئ عن هذه الفكرة وعدم تقبّلها.
وخلال قراءة رواية (بين جنّتين) سيصطدم القارئ بعدد كبير من الأخطاء اللّغويّة التي كان من الممكن تفادي كثيرا منها بقليل من المراجعة والتدقيق. فحبّذا لو بذل الكاتب والمدقّق اللغوي جهدا أكبر في تنقية الكتاب من هذه الأخطاء التي تتكررّ بشكل ملحوظ.
وقد أحسن الكاتب عندما جعل موسى يقفز عن جدار الفصل الذي يحيط بالقدس ويصل إلى المسجد الأقصى المبارك. ففي جنّتيه: فلسطين والعراق، فصلت الجدر بين أبناء المجتمع الواحد والأمّة الواحدة. ففي الأولى بنى المحتلّون جدارا حقيقيّا من الخرسانة والأسمنت ليقسّموا الوطن الواحد والشّعب الواحد، وأمّا في الثّانية فقد بنى المحتلّون جدرا من الطائفيّة والكراهيّة شتّتت شمل الشعب الواحد وقسّمته. وإن استطاع موسى أن يتخطّى الجدار رغم صعوبة ذلك، فسيستطيع العراقيّون أن يتخطّوا الجدر الوهمية التي رُسمت لهم، وإن كان المسجد الأقصى المبارك هو المكان الذي لجأ إليه موسى، فما يمثّله هذا المسجد من قدسيّة وإيمان مشترك بين جميع الطّوائف في العراق سيكون هو ما تجتمع عليه قلوب العراقيّين من جديد. وما يعنيه هذا المسجد هو ما ستجتمع عليه هذه الأمّة لتصبح واحدة عزيزة قويّة.
وقالت وفاء داري:
رواية بين الجنتين للكاتب د. سرمد التاية والتي تقع في ٣٦٨ صفحة. عن دار النشر الرعاة والجسور عام ٢٠١٨. حينما نصادفُ عملًا أدبيًا ناضجًا ومبدعًا، جريء. ونشرع في تفكيكه وتشريحه متوغلين في أعماق النص لتتحول أقلامنا دون أن نشعر لمِبْضَعِ يُشرّح يحلل بنية السرد لنصل لأعمق طبقات اللاوعي الجمعي والفردي فيكشف الحزنَ بين جنتين (فلسطين والعراق) يغذي تيه الهُوية، والفقدَ كخريطة وجودية، والقهرَ كفيروسٍ اجتماعي، والخذلانَ كزلزالٍ جيوسياسي. في مواجهة هذه التراجيديا، ترفع الرواية الوجع مقاومةً، والعودةَ استعارةً لاسترداد الزمن الضائع، مُحوِّلةً الألم إلى سؤالٍ فلسفيّ يستدعي التأمل ويُعيد تشكيل الوعي، هكذا يصير النصُّ الأدبيُّ “أرشيفًا حيًّا” للصراعات الإنسانيّة؛ فالكلمات لا تُترجِم المشاعر، بل تُفكّكُها إلى شظايا تُعيدُ تشكيل وعيِ القارئ. فـ”العودة ” في هذا السياق ليست عودةً إلى مكان، بل هي رحيل نحو الذات في زمن تشظّي الهُويّات. وهذا ما يَجعل النقد الأدبيَّ مشروعًا ثوريًّا.
صورة الغلاف وعلاقته بالعنوان:
الغلاف لا يطرح جنّة بالمعنى التقليدي، بل يقترح وجود وهم مزدوج: جنتان مفترضتان، أو جنة ضائعة وجنة ممنوعة. البوابة التي تخرج منها الشمس تشبه حلمًا مؤجلًا أو (جنة مستحيلة). الشخصية الرمادية تقف في المنتصف، تمامًا كما في العنوان “بين”، فهي لا تنتمي إلى جهة واضحة. الألوان تنتقل من التراب والرماد إلى الماء والخضرة، مما يعزز فكرة التحوّل أو التباين أو الصراع الداخلي/الخارجي. وجدار إسمنتي رمادي: يُحيل بوضوح إلى جدار الفصل العنصري في فلسطين – رمز للاحتلال والعزل. شجرة نخيل وماء نهر: رمزان للخصب، الحياة، فلسطين الطبيعية الخصبة. شخص بظل أسود وحقيبة: يوحي بالترحال، الغربة، فقدان الهوية وربما الخروج القسري من “الجنتين”. أما الشمس المشرقة خلف بوابة: فيها رمزية الخلاص أو الأمل المؤجل. ونبات الصبار: رمز الصمود الفلسطيني والتجذر في الأرض.
الألوان: الأخضر: حياة، مقاومة، أمل. الرمادي: قسوة الواقع، الاحتلال. الأزرق: نهر، ربما يُحيل إلى نهر الأردن أو رمزية عبور/فقدان.
الزمكان: فضاءات النكبة والتيه
تتخذ الرواية من الزمكان بعدًا جوهريًا في بناء عالمها. فالزمن ليس مجرد تتابع للأحداث، بل هو تاريخ حافل بالنكبات، بدءًا من نكبة 1948 التي تشكل الخلفية الوجودية للبطل موسى، مرورًا بسقوط بغداد عام 2003، والثورات العربية التي أتت بآمال ثم تبعتها خيبات. المكان بدوره ليس مجرد خلفية ثابتة، بل هو فضاء يتنفس ويشهد على المعاناة. “فلسطين” و”العراق” ليستا مجرد دولتين، بل هما “جنتان” متصادمتان، تكتنفان مرارة الفقد والتيه. يتنقل بين فلسطين (الضفة الغربية، الحواجز، جسر اللنبي)، العازل العنصري ونقاط التفتيش، مثل جسر اللنبي، لا تمثل فقط حدودًا جغرافية، بل حواجز نفسية ووجودية تفرضها جغرافيا القهر، وبين العراق (بغداد تحديدًا – الجامعة والمجتمع)، والأردن كمعبر حدودي وسجن مؤقت. المكان في الرواية ليس فقط جغرافيًا، بل محمّل بالرمزية والتوتر السياسي والوجداني.
على الرغم من قوة هذه الدلالات، يلاحظ القارئ افتقارًا نسبيًا للوصف المكاني الحيوي في بعض الأحيان. فلوحات مثل نهر الفرات، جامعة بغداد، أو حتى تفاصيل حفل زفاف موسى في بغداد، كان يمكن أن تُثرى بوصف أكثر عمقًا وواقعية، يربط القارئ بالمكان ويجعله جزءًا من نسيج السرد، مما يزيد من إحساسه بالتراث والعادات والتقاليد والموروث الشعبي. هذا النقص الجزئي في التفاصيل البصرية قد يُفقد القارئ بعضًا من جماليات المكان، ويجعله يفتقد الشعور بعظمة بغداد التي ذكرت بشكل سطحي في بعض المواضع. هذه الملاحظات تظل ذات طبيعة جزئية، ولا تمس جوهر الرواية العميق والقيمة التعبيرية في الرواية.
الشخصيات الرئيسية:
موسى: البطل الذي يحمل اسمًا نبويًّا (تيهًا وخلاصًا). يجسّد معاناة الفلسطينيّ الباحث عن هويّة في منفى داخل وطن. البطل الرمزي والتاريخي، يحمل اسمًا يضرب جذوره في النفي والخلاص. شخصيته تجمع بين البسيط المعذب والمفكر المتمرد.
– نورا: ليست مجرد حبيبة، بل تمثيل رمزي للعراق الجريح، وللمرأة الممزقة بين الهوية والمجتمع.
– عمر: ضحيّة الطائفيّة العشوائيّة. يُقتل لأنه (عمر) لا لشيء آخر، في تجسيد صارخ لمرض الطائفية.
– الاحتلال والحدود والحواجز: تُقدَّم كشخصيات/أدوار لا كوقائع، لتلعب دور الفعل المضاد في الرواية.
الشخصيات: بؤر الصراع والوجود المتمزق
تتشكل شخصيات “بين جنتين” كنماذج حية لمعاناة فردية تتشابك مع قضايا جماعية معقدة. يتمحور السرد حول “موسى”، الشاب الفلسطيني الذي يحمل على عاتقه ثقل النكبة والتيه، ليس فقط الجغرافي، بل الهويات. هو يمثل جيلًا ورث مرارة التهجير، ويحاول أن يجد موطئ قدم في عالم يرفض استقراره. على الجانب الآخر، تبرز “نورا”، الفتاة العراقية التي تعيش هي الأخرى في زمن التشظي والانهيار الاجتماعي والسياسي. العلاقة بين موسى ونورا ليست مجرد قصة حب، بل هي محاولة وجودية لتجاوز الفروقات السياسية والجغرافية والثقافية، والعادات والتقاليد، والطائفية، والجيوسياسية، بل وحتى الفروق في المستوى المعيشي. إنها علاقة تجسد حلم الوحدة في عالم يمزقه الانقسام، لكنها أيضًا مرآة تعكس صعوبة تحقيق هذا الحلم في ظل التحديات الهائلة.
الشخصيات الثانوية، مثل “عمر”، تلعب دورًا محوريًا في إبراز عمق المأساة الطائفية. مقتله ليس مجرد حدث عابر، بل هو صرخة في وجه التعصب الديني الأعمى والمتأصل، الذي يمتد بجذوره إلى 1400 عام من الصراعات والخلافات. إنها تذكرة مؤلمة بما تعانيه دول المنطقة مثل سوريا والعراق من هذه الآفة. براعة السرد هنا تكمن في قدرتها على تجسيد هذا الصراع التاريخي في مصير شخصية واحدة، مما يحول الحدث الفردي إلى رمز للمعاناة الجماعية.
الأحداث:
تدور الرواية حول شخصية (موسى)، الشاب الفلسطيني الذي يحمل همّ الوطن والتيه التاريخي في قلبه، ويخوض رحلة وجودية تتقاطع فيها الجغرافيا والسياسة، والهوية، والحب، والموت. يعيش موسى معاناة الفلسطيني في ظل الاحتلال، والجدار العازل، والهويات المشتتة، ويقرر السفر إلى بغداد للدراسة. تتبع الرواية سردًا خطيًا رئيسيًا، بشكل عام حيث تتقدم الأحداث بشكل زمني متسلسل من بداية حياة موسى ودراسته، ثم تعرفه على نورا، وتطور علاقتهما، مرورًا بالأحداث السياسية والاجتماعية التي تعصف بهما، وصولًا إلى النهاية.
في العراق، يتعرف موسى على (نورا)، الفتاة العراقية الشيعية، ويقع في حبها، ليجد نفسه أمام صدام هائل بين الحب والطائفية، بين (السنّي) و(الشيعية)، وبين فلسطين والعراق، بين (الجنة الموعودة، والجحيم اليومي). تشهد الرواية تصاعدًا دراميًا حادًا عندما يُلاحق موسى من قبل الحشد الشعبي بسبب خلفيته الطائفية، ويضطر للهروب من بغداد بعد مقتل صديقه “عمر”، في مشهد فادح يرمز لتغوّل الكراهية المذهبية.
يعود موسى إلى فلسطين، فيُعتقل على جسر اللنبي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتُخضعه السلطات لتحقيقات مريرة ومهينة. تتداخل هنا الأسر داخل الوطن مع الهروب من الوطن، وتستمر الرواية في كشف فصول من الألم المتعدد الأوجه: الاحتلال، الاغتراب، الطائفية، والفقد الوجودي
تتوج الرواية بنهاية مفتوحة مجهولة المعالم عمدًا، لا لغياب القرار الفني، بل لأنها تُجسد التيه الفلسطيني-العربي الوجودي – مما يطرح سؤالاً فلسفياً عميقاً: لماذا ترك الكاتب القارئ أمام هذا الغموض؟ هل أتاح للقارئ حرية اختيار النهاية؟ أم أن هذه النهاية المفتوحة هي بحد ذاتها انعكاس لواقع الصراع والتيه الذي لا يزال مستمرًا؟ إنها تقنية سردية ذكية تحول الرواية من مجرد قصة إلى تجربة تفاعلية، حيث يشارك القارئ في بناء المعنى، وتؤكد على أن الأسئلة الكبرى حول الهوية والوطن لا تزال بلا إجابات قاطعة. هذه النهاية تتماشى مع الطابع الفلسفي للرواية، وتؤكد على أن الحياة نفسها غالبًا ما تتركنا أمام نهايات غير محسومة.
الأسلوب الأدبي:
جاء الاسلوب الادبي بلغة تجمع بين البساطة والعمق، متوازنة بين السرد الواقعي والتأمل الفلسفي، مع توظيف بارز للتناص القرآني والرمزية، خاصة في بناء الشخصيات. يتسم الأسلوب بالصدق العاطفي والواقعية والجرأة الفكرية، مع نبرة وجدانية تلامس القارئ دون مبالغة أو زخرفة لغوية زائدة.
اللغة: اللغة ناضجة ومتماهية بين الشعرية والتقريرية. ينتقل السرد من المباشر إلى التأملي، ويبرز أسلوب التايه في مقاطع التأملات الذهنية التي تُفضي إلى طرح فلسفي حول الهوية والوجود.
السرد: يعتمد على عدة تقنيات منها الخطي ومنها تقنية الاسترجاع والتنقل الزمني والمكاني (من فلسطين إلى العراق فالأردن) حيث برز بشكل كبير وغلبت على الرواية صوت الراوي الغائب العليم.
الاقتباسات القرآنية: موظفة بشكل واعٍ، خصوصًا تلك المرتبطة بسيرة النبي موسى، وهو توازي رمزي واضح مع شخصية البطل “موسى”، لتأكيد ثيمة التيه، النجاة، والهروب من “الطاغوت”.
التقنيات السردية: ومنها” المعلقات” والتي تمثلت في الاقتباسات الافتتاحية والتي أُخذت من داخل الفصل التالي، تساؤلاً حول تقنية (الخطافات- المعلقات- hooks). فبينما لا تفقد الرواية تشويقها، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الاقتباسات تحرق جزءًا من الأحداث، أم أنها تقنية مقصودة لتوليد نوع من الترقب المعرفي. أما من جانب توظيف النهاية المفتوحة يمنح الرواية بعدًا تأويليًا للقارئ، فيسهم في إعادة إنتاج النص.
الثيمات: نسيج من الوجع والمقاومة
النكبة والشتات والتيه: الرواية تُؤرشف لمعاناة الفلسطيني من النكبة مرورًا بالحصار والجدار العازل، ثم تربط هذه المعاناة بالجراح العراقية بعد سقوط بغداد، مما يجعل الرواية خطابًا جمعيًا للهوية الممزقة.
ثنائية الحب والسياسة: علاقة موسى بنوار ليست حبًا تقليديًا، بل اختبار واقعي للتشابك بين الحميمي والسياسي، بين الشخصي والعام. الحب هنا هشّ أمام التقاليد، والطائفية، والجغرافيا، والطبقية.
الهُوية والانتماء: صراع البطل ليس فقط مع “الآخر”، بل مع ذاته، مع انتمائه، مع معنى أن يكون (سنيًا) في أرض (شيعية)، فلسطينيًا في بغداد، ولاجئا في وطنه.
الطائفية والتاريخ الدموي: في الرواية اشتغال جريء على نقد الطائفية، خصوصًا من خلال قصة(عمر) وقتله بسبب الانتماء الديني. الرواية تُدين الفكر الموروث الأعمى منذ 1400 سنة، وتربط الماضي بالحاضر الدموي في العراق وسوريا.
الاقتباسات القرآنية والتناص: وظّفت الرواية التناص القرآني بشكل رمزي (مثل استخدام قصة سيدنا موسى في صفحة (99) واقتباسات أخرى صفحة(220و364)، لتأكيد الدلالة على المسيرة والمحنة والهروب/الخلاص. الاقتباسات لا تعمل كحلي نصية، بل تضفي عمقًا روحيًا وفلسفيًا على السرد، وتربط الأحداث بمفاهيم قدرية ووجودية، مما يعزز من البعد الفلسفي للرواية ككل.
الزمن المفتوح والنهاية المفتوحة: النهاية غير المحددة تدفع القارئ للتساؤل: هل عاد موسى؟ هل مات؟ هل تحرر؟ هذه النهاية المفتوحة ليست ضعفًا، بل تحاكي ثيمة “التيه “التي تحكم الرواية منذ عنوانها.
في الختام:
“بين جنتين” للدكتور سرمد فوزي التايه تتنفس الوجع والمقاومة، عملٌ أدبيٌّ ثوريٌّ، يُحوِّل السردَ إلى مشروعٍ نقديٍّ لإعادة تشكيل الوعي الجمعيّ. رواية ناضجة ومبدعة، لا تكتفي بسرد الأحداث، بل تتغلغل في مكامن النفس الإنسانية. إنها عمل جريء يرفع الوجع مقاومةً، والعودة استعارةً لاسترداد الزمن الضائع. إنها نص أدبي حي يعكس صراعات الإنسان في ظل التيه، والفقد، والقهر، والخذلان. الرواية تقدم رؤية عميقة لمأساة الهوية في زمن التشظي، وتثبت أن الكلمات، في أيدٍ مبدعة، لا تترجم المشاعر فحسب، بل تفككها إلى شظايا تعيد تشكيل وعي القارئ، وتجعله شريكًا في مشروع نقدي ثوري يُعيد طرح الأسئلة الوجودية الكبرى.
وقالت هدى عثمان أبو غوش:
رواية”بين جنتيّن”للكاتب الفلسطيني سرمد التايه، هي رواية اجتماعية، وطنية،انسانية، سياسيّة، تحمل وجوه عديدة،وجه الحبّ،وجه الفلسطيني المكافح الطموح للعلم رغم ظروفه الصعبة، وتبرز ملامح الحزن،والألم،القهر،وجه الحنين،التّحدي في وجه الصعوبات.
ووجه العراقي بألمه ومعاناته، وتظهر صورة العراقي الجميل في تعاطفه وترابطه الأخوي مع الشّعبي الفلسطيني،من خلال تكرار ذلك في النّص الرّوائي.رواية ينسجها الكاتب بضمير االغائب والرّاوي العليم بتفاصيل الأحداث.
بين جنتيّن”جنّة الأماكن فلسطين والعرّاق،تلك الجنتيّن لم يحظيا بالرّاحة، ففي العرّاق لم يقطفا بطلا الرّواية موسى ونورا ثمار سعادتهما إلاّ قليلابسبب الحرب،والاحتلال الأمريكي على العراق،وسقوط بغداد، ومقتل طفلهما على يدّ المليشيات الشّيعية المسلحة، بسبب اسمه “عمر”،واضطرار موسى للرّجوع لوطنه، جنته فلسطين الذي يقطن في الضفة الغربية، في هذه الجنّة تشتعل الأحداث السّياسية،والوجع والحواجز،القتل،والاعتداءات والتحقيقات.بالإضافة إلى جنتيّ الأماكن التّي تمثل الجماعة كوطن،فيقابلها جنتا الفرد المتمثلة بالعاشقيّن موسى ونورا،هي جنة الحبّ بين الفلسطيني والعراقية الشّيعية،وقد اشتعلت جنتهما بفتنة الطائفية والحروب.
“بين جنتيّن”العنوان ـ بين،ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، جنتيّن ،مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنّه مثنى.
والعنوان إشارة واضحة بأن مضمون الرّواية يدور حول الأماكن.
رواية “بين جنتيّن “هي صرخة تبحث عن الأمان في زمن الحرب،تبحث عن ضمير الإنسان،في مشهد مقتل الطفل الفلسطيني عمر، وتلعن شيئا اسمه الطائفية.
وتبحث عن الخلاص في المشهد الفلسطيني التراجيدي في صرخة موسى،وهو يجثو فوق ركبتيه في المسجد الأقصى في الانتفاضة، مشهد درامي تراجيدي،وبهذا المشهد جاءت النّهاية مفتوحة في جنّة فلسطين،نهاية تبحث عن مفاتيح الجنان.
جاء أسلوب الكاتب بلغة سهلة انسيابية جميلة،بين الّلهجة العراقية والفلسطينية،ممّا أضفى على نصّ الرّواية جمالا.استمتعت كفلسطينية بالّلهجةالعرّاقية.
أظهر الكاتب أن أحيانا الّلهجة العراقية تسبب عدم فهم للبعض في فهم سؤال معين كما حدث مع موسى.
صوّر الكاتب الحنين ما بين الجنتيّن،حنين موسى لزوجته نورا ولأطفاله عمر,علي،وسوسن،وحنين نورا لزوجها وقلقها عليه.
استخدم الكاتب تسلسل تطور الرسائل قبل الحرب وبعدها،الهاتف اللاسلكي وثم الهاتف الخلوي و”السكايب”،والرّسائل المكتوبة التي كانت الصلة بين موسى وأهله، وثمّ المسنجر.
استخدم الكاتب تذييلا في أسفل الصفحة ليوضح بعض المعاني الصعبة بالّلهجة العراقيّة.
كانت معظم الشّخصيات في الرّواية إيجابية،سواء الفلسطينية أو العرّاقية.
كان التنقل بالأماكن من القرية الفلسطينية في الضفة الغربية،الحواحز،السّجن،الأقصى والقدس،،الحدود الأردنية الإسرائيلية،بغداد.
ـ تم ذكر قضية زواج الشيعية من السّني وقد رزقا بالأولاد؟لم يتطرق الكاتب إلى أي خلافات بينهما من ناحية عقائدية،والأهم كانت معارضة من قبل فاضل أخو نورا لتزويج أخته من سُني،وقد وافق فقط بعد أن التقى به وأُعجب بشخصيته.والسّؤال هل زواج السّني من الشّيعية لم يسبب لهما أيّ إحراج في البيئة من حولهم في العرّاق،وفي محيط عائلة موسى في فلسطين! أم أراد الكاتب ذلك من أجل إحداث تغيير في الأماكن للإنتقال للجنة الأخرى أي في فلسطين؟
هناك سؤال بقي عالقا في ذهن القارىء ،ماذا حدث بالنسبة للأرض الذي رهنها والد موسى،هل سدّد الدّين،وهل عرف موسى.أم الجواب عليها في الجزء الثاني للرّواية؟
أحزنني أنّ ملاك بقيت مجروحة تنزف بخيبتها في تيه حبّها لموسى،لم يظهر الكاتب
معرفة والد ملاك ما حدث لإبنته الطالبة.
أظهر الكاتب العلاقة الوثيقة بين الشعبين العراقي والفلسطيني.وقد ظهر ذلك من خلال تعامل العائلات العراقية بحسن واهتمام تجاه موسى.ومن ناحية أخرى لاحظت تكرار الرّاوي في تصويره مدى اهتمام العراقي بالفلسطيني.
وقال بسّام داوود:
الرواية جميلة وردت باسلوب شيق يشد القارئ اللغة سهلة الرواية تصلح لان تكون مسلسلا تلفزيونيا .
تدور احداثها حول الشاب الوسيم الخلوق موسى ابراهيم عاش في اسرة بسيطة فقيرة في احدى قرى الضفة الغربية وضع هدفه دراسة الهندسة في البلد الذي احبه وهو العراق .
نجح في الثانوية العامة بمعدل 90% قرر السفر الى العراق لكنه لا يملك مصاريف السفر فقرر والده ان يقترض المبلغ المطلوب من مختار القرية مقابل رهن قطعة ارض له .
سافر موسى الى الاردن استخرج جواز سفر اردني مؤقت ثم اتجه للعراق والتقى بشباب فلسطينين هناك استضافوه لحين ان يتدبر اموره وبسبب تأخره عن موعد التسجيل في الجامعة لجأ الى السفارة الفلسطينية لكي توصي عليه لدى الجامعة لقبوله لكن السفارة لم تستطع مساعدته فيقرر الرجوع الى البلاد على ان يرجع في العام القادم وعند نقطة الحدود الاردنية يلتقي بضابط عراقي شهم اسمه ابو كاظم ما ان سمع قصته حتى تعاطف معه وقرر ان يعود معه لبغداد للتدخل لدى الجامعة من اجل قبوله هذا الضابط له مركزه الهام في العراق ما ان وصل لجامعة بغداد حتى رحبت به الجامعة وتم تسجيل موسى في كلية الهندسة وقام ايضا بايجاد السكن الملائم له عند احد العائلات العراقية .
تبدأ الدراسة في الجامعة ويبدأ موسى بالتأقلم مع هذه الاجواء الجديدة سواء في الجامعة او في منطقة سكنه متصرفا باخلاقه وادبه التي تربى عليها في فلسطين لينال حب الجميع واعتبروه خير سفير لبلده وشعبه .
انتظم في دراسته لمع بين اقرانه بسبب تفوقه وجده واجتهاده وشاءت الاقدار ان يدخل في منافسة مع طالبة عراقية من بنات قسمه وهي الطالبة التي صدمها الضابط ابو كاظم بسيارته عند قدومه مع موسى للجامعة للتسجيل ومنذ تلك اللحظة سحرته بعيونها وبدأت المنافسة بينهما لكنه تفوق عليها وبدا يشعر بشيء يخترق اضلاعه تجاهها كما بدأت هي تحس بنفس الشعور دون الافصاح عن ذلك فيما بينهم وتمر الايام وتتجدد نار المنافسة وتشتعل عوضا عنها نار الشوق والحب في قلبيهما .
اصبحت الدراسة محور حياة موسى لكن لا بد من رشفة عشق وازداد التقارب بينهما ورغم التنافس الشديد الا ان الحب لا يعرف الدراسة ولا المنافسة ولا يعترف بالجنسيات والقوميات والعقائد المختلفة .
يقرر دكتور القسم تكليف الطلبة بعمل مشاريع دراسية بان يشترك كل اثنين من الطلبة معا بنفس المشروع لتكون شريكة موسى الطالبة نوار ولتكون فرصة متاحة لهما للتعارف جيدا ليزداد تقاربهما وانسجامهما ولا يمر يوم دون لقاء وفي نهاية الفصل يتوجان مشورعهما بالحصول على الدرجة الاولى من بين كل المشاريع ليصدر قرار من الجامعة بتعيينهما كمعيدين نظرا لقدراتهما وتميزهما .
ازدادت مشاعر الحب بينهما وتواعدا على بناء العش المقدس مهما كانت المعيقات , اخبرت نوار اهلها بعلاقتها مع موسى هذا الشاب الفلسطيني المميز بادبه واخلاقه وجده واجتهاده وبناء على طلب والدها وجهت له الدعوة لزيارة اسرتهم فنال اعجاب والديها الذين اشادوا بالشعب الفلسطيني المناضل الا ان اخاها فاضل تحفظ بسبب اختلاف العقائد بينهما فالشعب الفلسطيني شعب مسلم سني وهذا الكلام تم رفضه من قبل الوالد المثقف ليقول كلنا مسلمين ونسير على خطى الرئيس صدام حسين الذي حارب الطائفية فلا فرق بين مسلم ومسيحي وسني وشيعي .
بدأ التفكير الجدي بالزواج وتقدم موسى طالبا يد نوار من والدها لينال الموافقة وتتم الخطوبة وكتب الكتاب ويخبر موسى اهله في الضفة الغربية لينال موافقة الجميع باستثناء والدته التي كانت تخطط لتزويجه من ابنة اخيها الفتاة اميرة .
ويحضر اهل موسى الى بغداد وتتم مراسم الزواج ليتناغم التراث العراقي ويمتزج بالتراث الفلسطيني بحضور مميز من الجانبين العراقي والفلسطيني وقد تكفل الضابط ابو كاظم بكل تكاليف العرس لانه يعتبر موسى بمثابة ابنه الوحيد الذي قتل في الحرب الايرانية العراقية .
ازداد تعلقهم ببعض وبنوا اسرة سعيدة متحابة ليلغوا اعتقادا عند البعض بان تكون العقائد المختلفة سببا في اختلاف النفوس وتباعدها .
بعد سنة رزقا بطفلين توأم ذكور اسموهما عمر وعلي تيمنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة علي بن ابي طالب وبعد سنتين رزقا بطفلة اسموها سوسن بدأ يكبر الاطفال وكان موسى يصطحبهم الى الضفة الغربية ليعرفهم بالبلاد والقضية ليحملوها كما حملها اباؤهم واجدادهم .
وبهذا يكون موسى ونوار قد حققا هدفهما ببناء اسرة مبنية على الحب والتفاهم وتحقق حلم موسى الذي تحدى الظروف وتحدى تقسيمات سايكس بيكو وجمع بين العراق وفلسطين جمع بين هاتين الجنتين فالشعب العراقي يحب الشعب الفلسطيني ويعتبر القضية الفلسطينية قضيته الاولى .
لكن العراق لن يسلم من شر امريكا التي احتلته وسقطت بغداد وانهار الجيش العراقي وعمت الفوضى في كل ارجائه ليزداد البطش الامريكي وتزداد الاعدامات وتدب الخلافات بين الطوائف المختلفة وتسيطر الميلشيات الشيعية المتطرفة المعروفة باسم الحشد الشعبي لتطارد كل ما هو سني مما اضطر موسى ليغادر البلاد ولو مؤقتا ليعود الى الضفة الغربية وتقوم المخابرات الاسرائيلية باعتقاله عند جسر نهر الاردن ليحكم عليه بالحبس الاداري ويتم تمديده لمدة خمس مرات متتالية ليضطر بالقيام بالاضطراب المفتوح عن الطعام لمدة 65 يوما لتتدخل منظمات حقوق الانسان ويتم الافراج عنه ليبدأ حياته من جديد لكنه ممنوع امنيا من مغادرة البلاد وافتتح مكتبا هندسيا وحقق نجاحا كبيرا . اولاده يكبرون ويدخلون المدرسة وترعاهم امهم نوار و ينتظرون اباهم ليعود اليهم لكن الفوضى تزداد في العراق وتزداد الاعدامات ويزداد القتل الذي انتشر في كل مكان لتنال يد الغدر الشيعية من الطفل عمر لا لسبب الا لانه يحمل اسم عمر ليحطموا قلب امه في العراق تحت الاحتلال الامريكي وقلب والده في فلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي .
وقال د. محمد كريّم:
تدور الفكرة العامة للرواية حول معاناة الشعب الفلسطيني تحت (الاحتلال الإسرائيلي)، مع التركيز على قصة الشاب الفلسطيني موسى الذي يسعى لتحقيق حلمه في دراسة الهندسة رغم الصعوبات التي تواجهه. تبرز الرواية أيضًا العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والعراقي، وتسلط الضوء على التضامن العربي مع القضية الفلسطينية.
تدور أحداث الرواية الرئيسية حول حلم موسى، الحاصل على نتائج جيدة في الثانوية العامة، في الضفة الغربية، بدراسة الهندسة المدنية في العراق، وما يعتري ذلك من صعوبات مالية وإجرائية في السفر.
يصل موسى العراق وتواجهه صعوبات إجرائية في تسجيل الجامعة إلى أن يتعرف على أبي كاظم، الضابط العراقي الذي يتبناه ويساعده في التسجيل بجامعة بغداد، حيث يتنافس مع نوار، على صدارة النتائج، وتتطور العلاقة معها من منافسة أكاديمية إلى مشاعر متبادلة، تزدهر مع تعاونهما في مشروع جامعي ناجح، يحطم حواجز الاختلافات، وسيل التحديات التي تواجه موسى والتي ليست تحديات الغربة والاختلاف الثقافي إلا جزءاً منها.
تجلّت الرمزية في عنوان الرواية “بين جنتين”، والتي ترمز إلى فلسطين والعراق، اللتين تمثلان جنتي موسى، وطنه الأم الذي يحلم بالعودة إليه، والعراق الذي منحه فرصة تحقيق أحلامه.
أما الأسلوب الأدبي، فقد حاول الروائي السرد الوصفي الدقيق للأماكن والمشاعر، في جين حاول الاعتماد على الحوارات لنقل الأفكار وتطوير الشخصيات، في حين عجت التشبيهات والاستعارات بالصور الشعرية والقرآنية في مواطن عديدة.
عانى الوسيط الرئيسي للكاتب، وأعني اللغة من الكثير من الإشكاليات، فلم يتقن الروائي الإمساك التام باللغة المستخدمة في الرواية، فقد كانت بعض التراكيب مشوّشة وغير متماسكة، ما يدفع بالقارئ إلى فقدان التسلسل المنطقي للأحداث.
كما عانت الرواية أيضاً من انزياحات لغوية مفاجئة بين مستويات لغوية مختلفة (فصحى/عامية/لغة شعرية/ صور قرآنية) دون مبرر سردي.
” اشبيك يا ابني، وبن سارح؟” (عامية عراقية) تليها مباشرة جمل فصحى مثل “سادت خلطة صمت”.
كما عانت الاستعارات والصور من الإبهام في مواطن عديدة مفرطة في التجريد أو غير واضحة الدلالة، كما افتقدت الرواية إلى الحوارات الثنائية، فعلى سبيل المثال لم يكن في الثلث الأول من الرواية كلها أكثر من حوارين فقط في حين عج النص بالكثير من الحديث عن الحوارات وعما دار فيها من أحداث. كما افتقدت حوارات الشخصيات للطلاقة، وظهرت بشكل متكلّف أو غير واقعي.
عانى النص أيضاً من عدد مهولٍ من الأخطاء اللغوية والنحوية، التي أستغربها كثيراً مع خضوع النص لتدقيق لغوي عميق، كما أشار المؤلف، والتي فيما يلي البعض اليسير منها:
إلى مزيداً ( 24) ما يسببه بطئ (33) كم حلمت أن أجوب بشوارعك (44) إلا أن مهند قد تدارك الموقف ( 45)
السكنات المجاورة (45) على الرغم من أنها لم تعر جل اهتمامها بالدراسة (65) ورسمت ابتسامة كبيرة من على ثغرها (62) وكل وأحد ( مكررة مرات عدة) (63 وغيرها) كأنه أب حاني (75) تدخل أبو كاظم وهو يحاول إطراء الجو(78) ظهر الغضب على ملامح أبو كاظم (81)/ مكررة كثيراً / تهبط دمعة من على خد أبو كاظم (84)
وغيرها الكثير الكثير.
عانى النص أيضاً من شرح ما لا يجب شرحه، والإفراط والمباشرة غير مبررة في الوصف، والذي أفترض وجوب تسلله وانسيابه من على أفواه شخصيات الروايا وفي سياقاتها المختلفة، (بلده الحبيب) (العدو الذي يمكن أن يطلق الرصاص) (صاحب العمل الذي جاء من أقسى بقاع الأرض) ممتلأ بآهاته والامه… وعايشها كما يعايشها الشعب الفلسطيني(33) الصك الغفراني، ويعني بها موافقة جيش الاحتلال (27) فالعمل التنظيمي بالدرجة الأولى هو انتماء… حيث أن الفلسطيني لا يمتلك جواز سفر (35). وأثناء التحقيق معه والتحقق من نبأ خيانته (35)
هذا وقد حاول اياد مراراً سحب الكلام منه واستدراجه ومعرفة …
أما الحدث الذي دار مع أبي كاظم ضابط المخابرات على الحدود، فكان اختزاله بحوار يحمل كل ما يلزم ويوفر الكثير من جهد الحديث عن الحوار (47)
ناهيك عن المبالغة في الإقرار والذي على الروائي تسريبه لا التصريح به. تدخل الاب الحكيم (66) أن أباها هو خير ناصر (67) والتي كان للأب الحكيم والأم الواعية (70) وآوى كل إلى فراشه راضياً مرتاح الضمير دون ان يكون هناك أية مغبة أو …. ووجهة يحمر وهو في قمة الخجل (76)
بعد الخروج من بيت أبي همام / وأن الورود بدأت تُفرش ( وضوح زايد)
ويصعدا إلى مكان مرموقٍ ( 88) من المنعة والتمكن والركازة (90)
أول ليلة يحتدم بها هذا النوع من الصراع.
( علم الأحياء التي هي الجذر الرئيسي والأصيل للطب…)
وأرى أنه ما من داعٍ لشرح كل هذه التفاصيل، والتي ليست من عمل الروائي، وإن كان لا بد منها فيمكن أن تتسلل في حوار أو تهبط في فكرة هنا أو هناك، وبالتالي فلا داعٍ لهذا النمط من الاسترسال، وكان من الأجدى التناوب بين التصريح والتلميح.
اتسمت الحوارات غير الكثيرة بالتكرار المخلّ لنفس الكلمات والعبارات بشكل مبالغ فيه يضعف الأسلوب، وعجّ النص بتقلبات غير واضحة، وغير مبررة في أزمنة الأفعال (ماضي/حاضر) داخل المشهد الواحد.
ناهيك عن الإطالة الوصفية التي لا تخدم الحبكة أو تطوير الشخصيات، مثل الوصف المطول لمشاعر موسى دون تقدم في الأحداث.
ناهيك عن انقطاع التصوّر، وبالتالي عدم القدرة على تكوين صورة ذهنية واضحة للمشاهد، فضلاً عن ضعف الاندماج العاطفي.
جميع ما تقدّم أثّر عليّ كقارئ صعوبةً في المتابعة، وفقدان التسلسل المنطقي للأحداث، وكنت أرى أنّه من الأجدى توحيد مستوى لغوي متّسق، يركّز على اختيار الفصحى والقليل من العامية، كما كنت أرجو من الروائي تبسيط التراكيب والعمل على حوارات أكثر طبيعية تتماشى مع شخصياتها، وتقليل الانزياحات البلاغية وضبط التتابع الزمني لتجنب الارتباك في سرد الأحداث.
كان الأولى بالكاتب العمل على لغة ترفع من جودة العمل الروائي، مع وجود فكرة بهذه القوة الأساسية، وتعزيز سرديتها اللازمة.
وقالت رفيقة عثمان أبو غوش:
اختار الكاتب عنوان الرّواية “بين جنّتين”؛ نظرًا لوصف حياة البطل موسى الشّاب الفلسطيني، بين عالمين أو بلدين مختلفين؛ (فلسطين والعراق)، حيث اعتبر البطل كلا البلدين عزيزين على قلبه. مثّلت فلسطين بلد الأم حيث ترعرع بها مع عائلته، وأبناء بلدته، وكانت العراق (الجنّة الثّانية) البلد الثّاني الّذي احتضنه، وأكرمه وعمل معيدًا بجامعته كمهندس وقدّر نجاحه، وأنشأ أسرة صغيرة من زوجة عراقيّة شيعيّة مع ثلاثة أبناء.
اختار الروائي سرمد، شخصيّة الرّاوي بلسان الضمير الغائب؛ والمُتحدّث بلسان شخصيّات الرّواية، وهو العالم بكلّ مجريات أحداث الرّواية، والتّعبير عن مشاعرهم ومكنوناتها. إنّنن استخدام ضمير الغائب، وليس بضمير الأنا تُبعد الشّك بتصنيف الرّواية تحت مُسمّى السّيرة الذّاتيّة.
شخصيات الرّواية محدودة جدّا والمُكوّنة من البطل موسى، وعائلته الفلسطينيّة، ونوّار وأسرتها العراقيّة؛ بالإضافة لشخصيّة الضّابط العراقي أبو كاظم. نجح الكاتب في تحريك الشّخصيّات، وفق الأحداث والمواقف، باستخدام اللّهجتين: الفلسطينيّة والعراقيّة.
مثّلت الرّواية قضيّة الصّراع الدّاخلي الّذي واجهه البطل، بين الحنين للوطن والرّغبة في الاستقرار، وبين الحب والخوف؛ ممّا يعكس التّمزّق النفسي، والبحث عن السّلام النّفسي؛ الّذي يحياه الفلسطيني في الشّتات، وتكرار النّكبات. يتمثّل الصّراع أيضًا في مواجهة تحدّيات الهويّة والانتماء في ظل الحروب والاحتلال. وصف الكاتب الصرّاعات الّتي يواجهها الإنسان الفلسطيني أثناء تنقّله من بلدة إلى أخرى، وعبور الحواجز بصعوبة وإذلال. “ربّما الجرح النّازف هناك عاد لينزف من جيد، وبالتّالي كان لا بدّ الاكتواء بجحيمين بين جنّتين” ص 265.
نجح الكاتب سرمد في تصوير الصّراعات الطّائفيّة في العراق، أثناء الحرب عليها، والوجود العسكري الأمريكي؛ أبرز الكاتب ذلك من خلال الاعتداءات المتكرّرة من قِبل الشّيعة؛ على المواطنين السُّنيين، عندما ذكر الكاتب قتل الطّفل عمر (التوأم للطفل علي)، أبناء موسى على خلفيّة طائفيّة.
يتّضح من خلال السرد زمن الرّواية، ما قبل الوجود الأمريكي في العراق ما يقارب عام 2003 ولغاية عام 2006، أثناء إعدام صدّام حسين؛ حتّى نهاية الحرب عام 2011 متزامنًا مع الرّبيع العربي؛ وتخلّلتها الانتفاضة الفلسطينيّة الثّانية منذ عام 2000 ولغاية 2005. عاش موسى البطل الصّراعات السّياسيّة بين فلسطين وبغداد في الأزمنة المتزامنة؛ ما بين حرب واحتلال. هنا ققصد باكتوائه بجحيمين.
استخدم الكاتب اللّغة العربيّة الفصحى السّهلة والسّابرة، إلّا أنّه أدخل اللّهجتين العاميّتين (اللّهجة الفلسطينيّة والعراقيّة)؛ برأيي الشّخصي: ظهرت المبالغة في استخدام اللّهجة العراقيّة، فهي لهجة ليست سهلة على مسامع القارئ، على الرّغم من وجود ترجمة لبعض الكلمات. حبّذا لو تمّ التّخفيف منها. برزت اللّغة بشاعريتها ورمزيّتها. يبدو بأنّ الرّواية بحاجة إلى تنقيح لغوي من جديد، وأحمّل دار النّشر على إخراج الرّواية في صورتها النّهائيّة.
امتازت الرّواية في تصوير العاطفة بكافّة أشكالها: عاطفة الحب والعشق، الّتي تتمثّل في علاقة البطل موسى مع حبيبته نوّار العراقيّة، وعاطفة الفرح عندما زار أهل موسى العراق ” كم كانت فرحتهم عظيمة وهم يتجوّلون ويطّلعون على معالم هذا البلد، وبنائه العظيم، وأصالته في احتفاظ سكّنه بعروبتهم وتحدّيهم للغزاة” ص 256. ظهرت عاطفة الفرحة أيضًا عند مراسيم زواج موسى ونوّار “أضفت أم موسى أجواء الفرح الفلسطيني الأصيل على بعض الفقرات بمشاركة الشّباب والصبايا أبناء الجالية الفلسطينيّة هناك، ممّا زاد في روعة اجتماع وتناغم التّراث العراقي وامتزاجه بالتّراث الفلسطيني؛ ممّا أضفى عليه حسن الجمال وروعة الإتقان.” ص 259.
بينما طغت عاطفة الحزن على عاطفة الفرح، بسبب الجرح النّازف في العراق “بغداد جروح نازفة”، “ضيق في ثناياه فرج”، تدمع عينه على ما حلّ له، وحلّ للمدينة الحزينة” ص 361.
تبدوعاطفة الحنين للوطن قويّة اثناء وجود البطل في الشّتات، وأثناء عودة البطل لوطنه واشتياقه وحنينه للعراق ولعائلته؛ عاطفة الحزن الّتي ألمّت بموسى البطل وهوبعيد عن عائلته، طغى حزنه على فراق ابنه عمر، الّي قُتل على خلفيّة عنصريّة، وحزن العائلتين على فقدانهم الأليم، وعلى ما آلت إليه الأوضاع السّياسيّة والاجتماعيّة في كلا البلدين؛ ليس هذا فحسب، بل حزن موسى عللى فقدان صديقه الضّابط العراقي، الّذي تبنّاه وسانده في الغربة، وأغتيل على خلفيّة طائفيّة. اضحت المشاعر تائهة كما بدت على حياة موسى “والله يا بني صحيح أنت في عالم غير عالمنا أنت عايش ومش عايش، عايش في جسدك عنّا، بس روحك وأفكارك وخيالك مش عنّا.” ص 340. طغت العاطفة الوطنيّة والانتماء بشدّة، حب الوطن وحب بغداد وطن البطل الثّاني، وللقدس ظهرت عاطفة قويّة، حيث احتوت كل الآلام، وكانت هالة مقدّسة لاستقطاب الطّاقة السّلبيّة، وشحذ الهمم والعاطفة، بطاقة الإيمان والتّقرّب إلى الله.
ظلّت نهاية الرّواية ممفتوحة، حيث انتهت بزيارة البطل موسى لمدينة القدس، عند عودته للوطن؛ فوصف باب العامود، وبعض معالم القدس، وصلّى بالأقصى الشّريف؛ رافعًا يديه للأعلى، ورافعًا بأعلى صوته “عمر”. برأيي: إنّ النهاية المفتوحة تجعل الرّواية أقرب للواقع، وتعمّق العلاقة بين النّص والقارئ؛ وربّما أراد الكاتب أن يشير بأنّ الحل السّياسي غير بسيط أو نهائي، وقد تدل على استمرار الصّراع في فلسطين والعراق. أحيانًا تترك النهاية مفتوحة؛ لتلّمح إلى أمل محتمل دون تأكيد. يبقى السّؤال يراود القارئ: هل سيعود موسى إلى بغداد، ويجتمع مع زوجته نوّار وأسرة والدها جاسم، هل سيعود ليكحل عينيه برؤية أبنائه: (علي وسوسن)؟ هل ستتوقّف الصّراعات ويحل السّلام في الوطن العربي؟ وإلى متى؟. أسئلة كثيرة ستتوارد في ذهن القارئ.
خلاصة القول: رواية “بين جنّتين” تعتبر رواية واقعيّة، وتوثّق مرحلة هامّة في حياة العالم العربي؛ وخاصّةً في فلسطين وبغداد، في الزّمن المذكور أعلاه؛ هذه الرّواية تعكس الصّراعات الإنسايّة، والتّقارب، والامتزاج الثّقافي والحضاري والاجتماعي بين الشّعبين. هي رواية فريدة من نوعها، وممتعة ذات لغة بسيطة، وأسلوب السّرد فيها ممتع، يتخلّله الحوارات الخارجيّة والدّاخليّة؛ وتبرز فيها العاطفة الحزينة. تستحق هذه الرّواية التّرجمة للّغات الأجنبيّة المختلفة.
من الممكن اعتبار هذه الرّواية ملحمة إنسانيّة فلسطينيّة، وهي نوع أدبي فنّي يُصوّر تجربة بشريّة عميقة وشاملة، تُجسّد فيها معاناة الإنسان الفلسطيني والعراقي؛ من معاناته، وصراعاته، وتطلّعاته، وآلامه وآماله، عبر مشهد كبير يمتد غالبًا في الزّمان والمكان. فيها بُعد تاريخي أو وطني، او وجودي.
نصيحة مُقترحة للكاتب : روايتك أثّرت فيّ بعمق، وتركت لديّ تساؤلات ومشاعر لا تزال عالقة بعد النّهاية المفتوحة. شعرت أنّ الرّواية لم تنتهِ بعد، وأنّ الشّخصيّات ما زالت تملك الكثير لتقوله؛ نظرًا للأحداث الدراميّة المتتالية على امتداد العالم العربي. أتمنّى أن تفكّر بجديّة في كتابة جزء ثانٍ؛ فصوتك الأدبي يستحق أن يُسمع أكثر، ونحن كقرّاء متشوّقون لاستكمال الرّحلة.
وقالت نزهة الرملاوي:
امتدّ زمن الرّواية من تسعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.
تطرقت الرواية إلى الواقع الفلسطيني والعربي المعاصر، وما نتج من تحولات جذرية في المنطقة العربية وخاصة في العراق نتيجة الحروب وهيمنة الغرب على العرب وبلدانهم، بسبب تفككهم وتخاذلهم ومناصرة المحتل.
بينت الرّواية أثر هذا الصراع الدولي على حياة الفلسطيني في وطنه وخارج وطنه.
تصنف الرّواية ضمن الأدب الإنساني، الأدب الملتزم بقضاياه العربية القومية المصيرية، والذي وجد ليواصل كفاحه في فهم مدلولاته، وغرس قيمه ومفاهيمه وإعطائه المساحة الأكبر عبر الرّواية العربية.
عرضت الرّواية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، نتيجة سيطرة الاحتلال على المدن والقرى وإقامة الحواجز، وعدم إعطاء المواطن الحرية للتنقل أو السفر، مما يقلل من فرص العمل والتعلم
ومن الصعوبات التي واجهت البطل، صعوبة الحصول على المال لإكمال تعليمه، للوصول إلى العراق، بعد اجتيازه امتحان الثانوية العامة.
فيلجأ الأب إلى بيع أرضه ليمكّن ابنه من تحقيق حلمه في التّعلم.
أشارت الرّواية لدوافع البطل الشخصية وتصميمه على دراسة الهندسة في العراق، ذلك القطر الذي يحلم بالتعلم به، البلد الذي يحبه ويحسّ بأنه وجهة أمنه وأمانه، فهل تحققت أحلامه، أم صادفت سفن أحلامه رياحا لا يشتهيها؟
أشار الكاتب إلى عشق موسى لجنتين اكتوى بنارهما، وهذا ما كشف عنه عنوان الرّواية (بين جنتين) جنّة الوطن فلسطين وجنّة العراق الحلم.
ومن الصعوبات والمشاكل الاخرى التي تطرق لها الكاتب، هي الانتظار المرير على الجسرين للحصول على تأشيرة مرور سواء من الجانب الاسرائيلي او الجانب الأردني، واحساسه بالذل والخوف. وإغلاق للحدود وغرف للتحقيق.
اصطدام الطالب بعد وصوله إلى العراق بأقسى قرار، وهو عدم تسجيله بجامعة بغداد، بسبب انتهاء المدة التي يسجل بها الطلبة موادهم التعليمية.
بصورة تشويقية بيّن الكاتب حالة من المدّ والجزر والتي جرت في مكتب التحقيق للمخابرات العراقية، وذلك من خلال الأسئلة الدقيقة والتفصيلية الموجة للطالب موسى، وحالة الانفراج التي أتت بغتة من قبل الضابط ابو همام الذي يعشق فلسطين والفلسطينيين، ويريد أن يكون معهم في معركة التحرير، ويبدي تعاونا مع بوسف، ويقوم بتسجيله في الجامعة، ويساعده في ايجاد سكن عند أحد أصدقائه.
وإبراز حالة الحب والاحترام والتمجيد والاحتواء التي يتلقاها الفلسطيني من قبل أخيه العراقي، نتيجة صموده ودفاعه عن أرضه.
تطرقت الرّواية إلى حالة الضّغط والتّنافس العلمي بين الطلبة وخاصة بين طلبة البلد والطلبة المغتربين، مما يزيد من حدة الصّراع وعدم الارتياح.
وأشارت إلى إمكانية تحول حالة التنافس والتنافر والعداء بين موسى
الفلسطيني ونور العراقية إلى حالة من العشق والتفكير يواجه صعوبات جمة للاستمرارية،وعدم التفكير بالتراجع.
تثير الرّواية اسئلة كثيرة عميقة تنبع من الغربة والمعيق السياسي وإغلاق الحدود وفرض القيود والتفتيش المهين على المعابر، التفكير من قبل المحبّين بجديّة، كيف يمكن تخطّي تلك البيئات المتباينة والظروف المختلفة للاستمرار معا؟
وكيف يمكن للزواج المنطلق من الحب والعشق أن يبقى على نار الغربة التي تثمر طفلا، ليس له ذنب ان يعيش غربة الزّمان والمكان نتيجة الحروب وتسلّط المحتل.
بينت الرواية مدى تأثر موسى من حصار العراق، وسقوط العاصمة بغداد القاسي على نفسيته وعلى علاقاته الأسرية.
أثار الكاتب قضيّة مهمّة، وهي التباعد الأسري القسري، فكم من اسرة تعيش في هذه الحال المضنية المعذبة بلا استقرار اسريّ، وبلا أمان سياسيّ، فيؤدي ذلك إلى حالة من هروب الذات إلى ذات غامضة مكتئبة.
وجه الكاتب نظر القارئ إلى أثر القرارات السياسية التي جعلت الفلسطيني الذي ساند العراق في محنته وحربه، محطة للقمع والتشريد والترحيل ضمن سياسة العقاب الجماعي، وهذا ما واجهته الأسر الفلسطينية في الكويت ايضا.
أضافت الرواية بعدا تاريخيا لحرب الخليج الثانية، ووقوع العراق بين أيدي المحتل الأمريكي الذي قتل وشرد أبناءه، ونهب خيراته، وعمل على إشعال فتنة الطائفية والقبلية والعشائرية لتزيد معاناة المواطن العربي عامة والفلسطيني خاصة من الصدمات النفسية والمشاكل السياسية والاقتصادية وعدم الارتياح في جنته التي يحلم.
اختتمت الرواية بحلم الدخول الى القدس، تلك المعشوقة التي تتخطر عشقا في قلوب المحبين، وبعد عشرين عاما يدخل موسى وبعض المحرومين القدس تهريبا، فمن الصعب الوصول إليها دون تصريح للدخول.
نجح الكاتب في رسم مشاهد الوصول، منذ صعوده لمركبة أقلته مع آخرين إلى القدس، طريق حافلة بالمخاطر والمغامرة، حيث الجدار الأفعوان الذي شطر المدينة، والسلالم المرتفعة والحبال الغليظة والمجهول الذي يتربط بالمغامرين، حتى أطلت المدينة بوجهها وسرقت أفئدة عشاقها، والتحم المغامرون بجموع الناس عند باب العامود، وما أدراك ما باب العامود، ودخول موسى سوق باب خان الزيت وسوق العطارين ومشاهدة القناطر والباعة وتغلغل عبق الحارات والأزقة في ثنايا روحه، حتى وصوله إلى باب الأسباط وحدوث استنفار بين الجنود هناك، نتيجة حادثة طعن، وعلى ما يبدو أن الكاتب أشار لحادثة كانت على اعتاب باب المجلس (باب الناظر) وهو الأقرب للأسواق وسير موسى نحو الأقصى، ومن هناك ترحب قبة الصخرة بزوارها.
تمنى الكاتب أن ترافقة زوجته وأولاده إلى المدينة كما يتمنون ويحلمون.
أشار الكاتب إلى بعض ما آلت إليه المدينة من تنكيل وتهويد وقتل متعمد.
لغة الكاتب كانت انسيابية سلسة واضحة وذات أسئلة عميقة تفتح باب التخيل أمام القارئ، أما بالنسبة للّهجة العراقية العامية، فقد كانت في محلّها ولكن جاءت بمواقع عديدة وبصورة كبيرة لافتة.
تباينت العواطف لدى الكاتب كعاطفة الحب والأمل والألم والعشق والحزن والاشتياق، ومشاعر الفقد والتيه والخوف والقلق والفرح.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اختار الكاتب جهاد القدومي ليهدي له هذا العمل؟ هل كان أحد أبطال الرواية؟؟