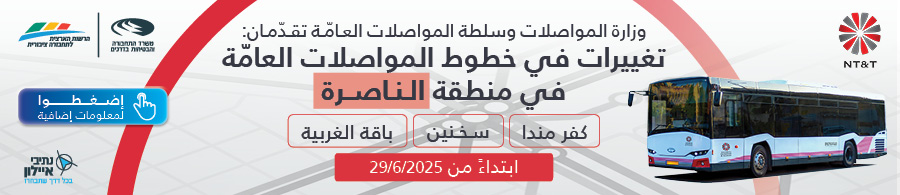في فقه المناصرة والدفاع عن العلم
الدكتور حسن العاصي أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
تاريخ النشر: 07/07/25 | 14:20
يتكثف النقاش داخل الأوساط الأكاديمية حول مشاركة العلماء في مناصرة قضايا الحريات والعدالة، ومن ضمنها مناصرة القضية الفلسطينية. مع تزايد عدد المشاركين من العلماء والباحثين، وأساتذة وطلبة الجامعات حول العالم، في الفعاليات لدعم فلسطين ومؤازرة الشعب الفلسطيني، وتزايد الدعوات إلى مقاطعة مراكز الأبحاث والجامعات الإسرائيلية من قبل عدد من الجامعات الغربية، ومقاطعة الفعاليات التي يشارك فيها علماء وباحثين إسرائيليين، فإن هذا التوجه يثير انتقاداتٍ داخل بعض الأوساط العلمية، ومن قبل بعض الأكاديميين الذين يخشون من أن تُقوّض المناصرة الحياد العلمي وتُثير مزاعم تحيز العلم وإساءة استخدام السلطة. على الرغم من ذلك، يرى بعض العلماء أن الدفاع عن المظلومين ونصراهم، والتصدي للظلم وفضحه هو واجب عقلي وفطري، تمليه القيم والأخلاق الإنسانية، ودفاعٌ عن مصداقية العلم. توجد مخاوفٌ بشأن استقلالية العلماء ودورهم في المجتمع في كلا طرفي النقاش، مما يُبرز التحديات التي يواجهها العلماء حالياً. وبينما لا يراهن البعض على مدى مقبولية المناصرة، فيما يقترح البعض أن يُشارك العلماء في نقاشاتٍ حول واجباتهم، وأن يُحدّدوا أنواع القيم التي تُعتبر مقبولة للتضمين في التواصل العلمي حول مناصرة القصايا العادلة. لكنني بصفتي باحثاً فلسطينياً فإنني أنحاز بالكامل لفكرة مشاركة العلماء والأكاديميين ـ بالكلمة، والموقف، والممارسة ـ في مناصرة كافة القضايا التي تمس الإنسان ومستقبله في هذا الكون، ومن ضمنها على سبيل المثال: قضية التغير المناخي، البيئة، حقوق الإنسان، السلام والأمن، الفقر والجوع.. الخ، وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية.
المناصرة – دفاع عن العلم أم تدميره؟
تثير الطبيعة المسيسة والمستقطبة للغاية لنقاش المناصرة تساؤلات حول مكانة العلماء والباحثين ودورهم المجتمعي. يؤكد العديد من مؤيدي المناصرة إلى أهمية دور العلماء الحيويً في مناصرة قضايا العدالة في العالم، حيث يساهمون في كشف الظلم وتقديم الحلول، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العدالة. ويجادلون بأن مشاركة العلماء أمر مبرر لأنهم يعتبرونها مسؤولية اجتماعية أساسية للعلماء في أوقات الأزمات. تماماً مثل مشاركة العلماء في قضايا أخرى تهم البشرية مثل البيئة وتغير المناخ، ويدعون إلى المشاركة علناً وسياسياً، مثل عالمة الجغرافيا البشرية البريطانية “كيرستي هوبسون” Kersty Hobson، وعالم البيئة الأسترالي “سيمون نيماير” Simon Niemeyer، وعالمة المناخ النيوزيلندية “أميليا شارمان” Amelia Sharman. إن العلماء والأكاديميين مواطنين، كغيرهم من الناس، وبالتالي عليهم التزام بالانخراط في النقاش السياسي والسياسات، لأنه إذا لم يفعلوا فإن القرارات تُتخذ من قِبل أولئك الأقل دراية بالمنهج العلمي، والذين لا يملكون فهماً جيداً للحقائق مثل العلماء. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن الصراع المحتمل بين الدعوة، والمناصرة، والمشاركة، والسعي إلى علم موضوعي خالٍ من القيم. حيث
يُقال إن الانخراط في مناصرة السياسات قد يؤدي إلى تصور أن المعرفة العلمية تتأثر بشكل غير مشروع بالقيم السياسية، أو أن الخبراء يسيئون استخدام مناصبهم الموثوقة لخدمة أجندات سياسية. وبالتالي، يهدد هذا التصور بتقويض المصداقية والموضوعية العلمية.
ومع ذلك لا تزال هناك أسئلة أكثر جوهرية غير مستكشفة، مثل لماذا لدى العلماء هذه المخاوف والأدوار التي يعتقدون أن العلماء يجب أن يلعبوها في المجتمع. هناك بُعدين أساسيين يجب استكشافهما: المخاوف المعرفية المتعلقة بنزاهة المعرفة العلمية وموضوعيتها ومصداقيتها. والمخاوف الوجودية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات العلماء في سياق مجتمعي.
يُظهر كثير من العلماء أن لديهم شعورٌ قويٌّ بواجب إيصال نتائجهم إلى الجمهور وصانعي السياسات. كما يؤكد العديد من فلاسفة العلم أنه لا يمكن فصل العلم عن القيم، وبالتالي فإن الدعوة إلى علم خالٍ من القيم غير ممكنة، بل غير مرغوب فيها. ما نحدده على أنه “علم جيد” يتشكل من خلال الأحكام القيمية. القيم جزء من كيفية عمل العلم؛ إنها تشارك ـ بشكل مشروع ـ في الأحكام العلمية التي يصدرها العلماء أنفسهم، وكذلك في فهم وتقييم الدور الذي يلعبه العلم في المجتمع. إن خطاب القيم في العلم ذو صلة في سياق المناصرة، حيث يطبق العلماء المنخرطون في المناصرة أحكاماً قيمة إضافية في كيفية وما يدافعون عنه، مثل نظرتهم السياسية للعالم.
يكمن قلق البعض في أن القيم السياسية المرتبطة بالمناصرة قد تمارس أيضاً تأثيرًا غير مقبول على إنشاء المعرفة العلمية، مما يؤدي إلى علم متحيز أو “المناصرة الخفية”. ومع ذلك، فإن مجرد الانخراط في المناصرة السياسية لا يعني تلقائياً أن القيم السياسية قد أثرت بشكل غير مقبول على إنشاء المعرفة العلمية.
العلم والسياسة
“طرحت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا” Foundation for the Science and Technology في عام 2020 ـ وهي مؤسسة بحثية بريطانية، تُوفر منصة محايدة لمناقشة قضايا السياسة التي تتضمن عنصراً من العلوم أو التكنولوجيا أو الابتكار ـ سؤالاً مُلِحًاً حول العلم والسياسة: “كيف يُمكن الجمع بينهما والحفاظ على انفصالهما؟”.
تمحور النقاش، حول السبل التي يُمكن ـ بل وينبغي ـ من خلالها اتخاذ القرارات السياسية بناءً على المعرفة العلمية. خلال هذه العملية، ناقش المشاركون دور الاستقلال العلمي، وضرورة فصل العلم عن النفوذ السياسي، وإلى أي مدى ينبغي أن يشمل “العلم” الدراسة الأكاديمية الأوسع للمعنى، بما في ذلك العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية.
لا شك أن العلم والسياسة يتقاطعان بطرق عميقة وهامة، هل يمكن فصلهما؟ من منظور التاريخ الثقافي، لطالما كان العلم سياسياً. إن “المعرفة” مفهوم ديناميكي وقابل للاكتشاف. وهو أيضاً مفهوم ذو موقع تاريخي. قبل القرن التاسع عشر، كان الشعر والبلاغة والفلسفة الأخلاقية تُعتبر جميعها بنفس أهمية “العلم”، إذ كانت تُعلّم تقدير الجمال والخير والحقيقة. في أواخر القرن الثامن عشر في ألمانيا، كما جادل الأكاديمي الألماني “باس فان بوميل” Bas van Bommel كانت هذه المواد الإنسانية تُمثّل في الواقع تعليماً إنسانياً من عصر النهضة، وتُفسّر على أنها “العلوم الدقيقة” (schöne Wissenschaften) على عكس العلوم الجامعية (اللاهوت والقانون والطب)، والعلوم العليا (höhere Wissenschaften) التي شملت الرياضيات والفيزياء. وبالتالي، يُمكن اعتبار أي تخصص، مجتمعًاً “علميًا”، شريطة أن يتبع المنهج الاستقرائي الأساسي لاستخلاص النتائج من الأدلة (البيانات).
أما اليوم، فقد أصبح تعريف العلم أضيق بكثير، ويقتصر على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). يعكس هذا التحول التغييرات التي طرأت خلال القرن التاسع عشر في تعريف بعض التخصصات وترتيبها هرمياً باعتبارها أكثر قيمة – وأكثر ارتباطاً بالموضوعية و”الحقيقة” – من غيرها. وهكذا، فبينما كان يُنظر إلى الفن في السابق على أنه يكشف عن حقائق جوهرية عن الطبيعة البشرية والوجود الأخلاقي، فقد أصبح، بحلول عهد الفيلسوف الألماني “فيلهلم تراوغوت كروج” Wilhelm Traugott Krug (1770-1842)، مجرد “عرض لما يُرضي الجمال”. في المقابل، لم يكن العلم “مهتمًا بذلك قط، بل فقط بإنتاج الحقيقة أو بالأحرى اكتشافها”.
فقط”.
لا تزال فكرة العلم كاكتشاف للحقيقة والفن كجماليات محورية في التسلسل الهرمي بين الفنون والعلوم الإنسانية في التعليم الغربي. من المألوف أن يدافع وزراء العلوم في الغرب عن قيمة العلوم الإنسانية. فهذه، في نهاية المطاف، هي “التخصصات ذاتها التي تجعل حياتنا جديرة بالعيش. إنها تُمكّننا من التفكير النقدي والتواصل. إنها تمنحنا بوصلة أخلاقية نحيا بها. إنها تُعزز تقديرنا للجمال، وتساعدنا على فهم أصولنا، بل وإلى أين نتجه. ومع ذلك، فإن العلوم الإنسانية ليست مجرد مرشد للحياة، بل هي أيضاً بالغة الأهمية لفهم كيفية وأسباب اتخاذ الناس لهذه القرارات، وكيف تنشأ وتتطور المعتقدات، وكيف يُفضّل شكل من أشكال الحجج على آخر، ولماذا يُعدّ مبدأ الموضوعية بالغ الأهمية، بل وإشكالياً، لعلم القرن الحادي والعشرين وسياساته.
إن إدراك هذه التفاعلات الحتمية بين العلم والسياسة – بدءًا من تحديد ما هو مهم، وصولاً إلى من يمكنه القيام بالحساب، ومن الاستدامة الاقتصادية للبحث إلى نطاقه الدولي وتطبيقه – أمرٌ بالغ الأهمية. فإذا لم يكن العلم موضوعياً وسياسياً دائماً، فإننا بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على ضمان تكامل القيم العلمية مع القيم الأخلاقية والاجتماعية.
العلم والأخلاق
يبدو أن العلم والأخلاق مجالان منفصلان تماماً، فلا صلة بينهما. في حالة اتباع العلم لمنهجه، من الضروري التسليم بصحة البحث وملاءمته؛ فلا حاجة للنظر في الأخلاق إطلاقاً. ومع ذلك، إذا قيل إن على الباحث اتباع قواعد المنهج العلمي بأمانة، وهو قيد أخلاقي بحد ذاته، ثم استنتج أنه من المستحيل وجود علم بدون أخلاق، فإن الحجة الأصلية مضللة نوعاً ما.
من الواضح أن أي كون ممكن قائم على مبادئه الخاصة التي يستحيل وجوده بدونها. تُشكّل المبادئ أساس الكون، لذا فإن رفضها يؤدي إلى دماره. نشأ العلم الحديث بعد تبني مبادئ معينة واتباعها. ألا يُعتبر هذا عملاً أخلاقياً؟ قد يختلف مفهوم “الأخلاق” باختلاف الناس. فالأشخاص الذين يلتزمون بالقواعد الاجتماعية والمبادئ العامة يُعتبرون محترمين، إلا أن سلوكياتهم وأفعالهم قد لا تُوصف بالأخلاقية.
مثلاً، السائق الذي يلتزم بقواعد وأنظمة القيادة أكثر احتراماً ممن يتجاهلها، لكن هذه القواعد والأنظمة ليست بالضرورة أخلاقية، ومن لا يلتزم بها ليس شخصاً لا أخلاقياً. وبالمثل، فإن التزام العالم بالمبادئ العلمية ليس عملاً أخلاقياً. بمعنى آخر، يوجد نظام في كل عالم يتكيف الناس معه غالباً بدافع العادة. فهل يجب أن نعتبر الأفعال المعتادة أخلاقية؟ القواعد الأخلاقية عامة وشاملة لدرجة أن تطبيقها يختلف باختلاف المواقف. أي أن الشخص الأخلاقي لا يقوم بعمل أخلاقي إلا في مواقف محددة عندما يكون على دراية بالتزاماته، ثم يقرر بناءً عليها. لذلك، يستدعي الفعل الأخلاقي الاعتراف بالتزام أخلاقي واتخاذ إجراءات لتنفيذه. لكن الوفاء بهذا الالتزام لا يعني بالضرورة عواقب إيجابية أو سلبية. فإذا كان منفّذ الفعل مُدركًا لنتيجة فعله وسببه، فإنه يكون خارج نطاق الأخلاق والحرية.
يبدو أن العلم والأخلاق لا يجتمعان، أو بالأحرى، الأخلاق تبدأ حيث ينتهي العلم. ولكن كيف يُمكن اتخاذ قرار في ظلام الجهل؟ اتخاذ القرار المبني على اليقين مستحيل في الأخلاق. يجب على المرء اختيار طريق، وقد يبدأ هذا الخيار بتحديد ما إذا كان أخلاقياً أم لا. كيف يُمكن اتخاذ قرار عندما يكون المرء غير متأكد؟ في عصرنا على الأقل، تبدو الأخلاق كمفارقة حيث يجب على المرء اتخاذ قرار عندما يكون اتخاذ القرار مستحيلاً. وهذا القرار فعل سلبي. أي أن المرء لا يتخذ قراراً أخلاقياً. لا يختار أحد الخيارات المتاحة. بل يتجنب بعض الخيارات وقد يواجه طريقاً مسدوداً، أو قد يجد الخيار الوحيد المتبقي له/لها. في مثل هذه الظروف، لا تُبنى الأخلاق على العلم، بل يتجاوز نطاقها نطاق العلم.
في هذا الجزء، لن تُثمر النقاشات حول العلم والأخلاق كمجالين مستقلين. قد يكون من المناسب النظر إلى المشكلة من منظور مختلف وطرح هذه الأسئلة: ما مكانة العلم والأخلاق في العالم الحديث؟ هل هناك أي تطابق بينهما في عالم الحداثة؟
لا يُمكن تصور العالم الحديث بدون العلم التكنولوجي. ففي هذا العالم، يتواجد العلم والتكنولوجيا في كل مكان، ويعتمد عليهما كل شيء تقريباً. في هذا العالم، لا يعتمد العلم ولا السياسة على الأخلاق، ولكل منهما أصوله وأسسه الخاصة. لكن هذا ليس نهاية المطاف. فالعلم والسياسة لا يحتاجان إلى الأخلاق، وفي النظام التقني-السياسي المعاصر، لا توجد عادةً حاجة لاتخاذ قرارات أخلاقية، لأن اتخاذ القرارات يتطلب التوافق مع النظام الكوني.
حتى العقود الأخيرة، كانت قيم العالم الحديث تُعتبر مطلقة. ويُعتقد أنه مع دخول الناس تدريجياً في النظام العلمي والفكري الحديث، سيقبلون قيمه ويدركونها على نطاق عالمي. مع ذلك، وبينما يتبنى معظم شعوب العالم، بما في ذلك شعوب الدول النامية، الرأي نفسه، يبدو أن هذا المنظور العالمي قد خف تدريجياً. فمع عولمة الاقتصاد والتجارة والتقاليد المعيشية وأنماط الإنتاج والاستهلاك، يقل احتمال تحقيق هذه القيم العالمية، بل حتى صحتها موضع شك.
ويتجلى هذا التشكك أيضاً في الممارسة والسياسة. وقد يُعتبر هذا التجلي غير مرغوب فيه، لا سيما عندما يتناقض مع القيم الغربية. في بعض الحالات، قد يتبين أنها عنيفة، وغير لائقة، وغير سارة، ولا يمكن الدفاع عنها. لم تكن هذه المظاهر موجودة حتى قبل خمسين عاماً. أما الآن، ونحن ننظر إلى الماضي، فحتى حركات مناهضة الاستعمار تُعتبر جهوداً لتبني قيم العالم الحديث.
أما الآن، فالوضع مختلف بعض الشيء. فهناك مؤشرات على اليأس من المستقبل، ولم تحقق الجهود المبذولة في التغريب والتحديث أهدافها المعلنة. يسعى الغرب جاهداً لتحقيق قيمه بأي ثمن، ولا يتسامح مع أي مقاومة أو اعتراض. يُقر الغرب بأن اعتراضاته لم تعد موجهة ضد السياسات والقمع، بل ضد إنكار وتدمير أسس الحضارة والسياسات الغربية. في هذا النزاع، العلم التكنولوجي متعدد الاستخدامات، ولم تجد الأخلاق مكاناً لها بعد.
بمعنى ما، من المقبول القول إن الدفاع عن القيم الإنسانية هو أخلاق، ولكن من الجدير بالذكر أنه لا ينبغي الخلط بين المعتقدات الشائعة والعادات الأخلاقية والقواعد الأخلاقية الصحيحة. المعتقدات الشائعة والعادات الأخلاقية مهمة، ولكن ما إن تُدافع عن هذه القيم بوسائل غير أخلاقية، حتى تتلاشى قوتها الأخلاقية. لقد أسس الغرب أنظمة سياسية وتقنية بالقوة الأخلاقية. فإذا كان هناك الآن مطلب للدفاع عن هذه المبادئ والتقاليد الأخلاقية بالسياسات والتكنولوجيا، فلا بد من وجود نواقص في تلك المبادئ والتقاليد.
قوة الأخلاق
تتطلب الأخلاق الصبر والثقة. إن السمات الأخلاقية التي صاغها رواد المعرفة (الحكمة، والشجاعة، وضبط النفس، والعدالة) كانت أخلاقاً، وليست نتاجاً لها. لا يجوز خلق هذه السمات أو الحفاظ عليها بوسائل غير أخلاقية. فالأخلاق بمعناها الحقيقي تسبق العلم والتقنية وعلاقات الناس. أما الأخلاق التي صاغها “كانط” في فكره، فقد تأسست على أساس العلم والتكنولوجيا والسياسة الغربية.
إذا فقدت الأخلاق قوتها وتأثيرها، فلا يمكن إحياؤها بوسائل خارجية. من المؤكد أن السلام والحرية لا يتحققان بالحرب والعنف، ولا يُنتج الانتقام والعداوة اللطف والصداقة. فهل من الممكن التوفيق بين المنتقمين باللطف؟ لا، إنهم يكرهون الإجماع والرفقة. ومع ذلك، فهم لم يحرموا العالم من الإجماع، بل ينتمون إلى عالمٍ يُلزم الجميع فيه بالامتثال لما يُملى عليهم. لا يملكون لغةً للتواصل مع الآخرين، وليسوا مستعدين للاستماع لما يقولون.
الحرية قيمةٌ عظيمة؛ فهي لا تتطلب القدرة على الكلام فحسب، بل تتطلب أيضاً التسامح في الاستماع. الأخلاق تقتضي قبول وجود الآخر. كلمات “جان بول سارتر” كاتب مسرحية “الجحيم” وسمّى “الآخر” جحيماً، كانت ذات دلالاتٍ كافكاوية. أي أنه كان قلقاً أيضاً بشأن الحالات التي لا يتمتع فيها الإنسان بخصوصية. ربما يكون قد أنكر وجود “الآخر” تماماً بوعيه بمعرفته “للآخر”، ونتيجةً لذلك، تجاهل الأخلاق تماماً.
إن إثارة مشكلة “الأنا” دون “الآخر” أمرٌ غير منطقي. منذ البداية، صنع الغرب لنفسه “الآخر”. هذا “الآخر” غير صالح للحوار والإجماع ما لم يُدرك حالته ويخرج من هويته المصطنعة ويبدأ الإجماع. الحرية تصبح ذات معنى إذا تحقق “الآخر”، وبقبول “الآخر” والتسامح معه، تستقر وتُحفظ. العنف، أينما كان، ومن أي جهة انبثق، ومهما كانت مبرراته، يُدمر الحرية والعدالة ويُهدم الأخلاق. لقد كان “الماركيز دي ساد” و”ديني ديدرو” الكاتبان الفرنسيان العظيمان، مُحقّين في قولهما إنه كلما انفصلت الحكمة والعلم عن الأخلاق والغايات الأخلاقية، فإنهما يعملان ضد نفسيهما ويلجآن إلى العنف والوحشية. يجب إنقاذ الحكمة والعلم والحقيقة. هذا هو المبدأ الأخلاقي الأصيل في عالمنا المعاصر.
تضامن الحركة الطلابية العالمية مع فلسطين
تصاعدت حرب إسرائيل الإبادة الجماعية على غزة في خريف عام 2023، وأشعلت شرارة انتفاضة طلابية جماهيرية في جميع أنحاء العالم. أعادت هذه الانتفاضة الطلابية تركيز الجامعات كساحات معارك حاسمة ومواقع تعبئة من أجل التحرير الفلسطيني. واستناداً إلى المناطق المحررة التي شهدتها الحركات الطلابية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بنى الطلاب “جامعاتهم الشعبية” من خلال بناء معسكرات في حرم جامعاتهم. والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأشهر الأخيرة. وشكلت الانتفاضة الطلابية الحالية تحدياً للأفكار الراسخة حول “أزمة” الجامعة، وتُزعزع استقرار الهياكل الإدارية العنيفة التي شكّلتها الجامعة أثناء إعادة تشكيل نفسها استجابةً لمطالب الاحتجاجات الطلابية السابقة.
لطالما كان تدمير التعليم العالي الفلسطيني هدفاً رئيسياً لحرب إسرائيل على غزة منذ البداية. في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية الجامعة الإسلامية في غزة، وهي مؤسسة تعليمية فلسطينية رائدة تخدم ما يقرب من ثمانية عشر ألف طالب. وعلى مدار هذا الهجوم المُبيد، دمّرت إسرائيل جميع الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة. ويُعدّ هذا التدمير المتعمد لجامعات غزة تصعيداً لحرب المئة عام على التعليم الفلسطيني. مُنع الفلسطينيون، في ظلّ نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي غير المتكافئ، من تطوير مؤسساتهم التعليمية الخاصة على مدى ثلاثين عاماً، وواجهوا جهوداً ممنهجة لمحو التاريخ الفلسطيني، وتدمير المدارس الفلسطينية، وقتل الطلاب والمعلمين الفلسطينيين منذ عام 1948.
قُوبلت الإبادة الجماعية في غزة وتدمير جامعاتها ومدارسها بانتفاضة طلابية حاشدة في الجامعات حول العالم. أعادت هذه الانتفاضة الطلابية تركيز الجامعات كساحات معارك ومواقع حيوية للتعبئة من أجل التحرير الفلسطيني. واستناداً إلى المناطق المحررة التي شهدتها الحركات الطلابية في الستينيات والسبعينيات، استعاد الطلاب البنية التحتية لمؤسساتهم وحوّلوها لبناء “جامعاتهم الشعبية” من خلال بناء معسكرات. وقد بدأ طلاب جامعة “ستانفورد” Stanford University أول معسكر في 20 تشرين أول/أكتوبر2023 واستمر لأكثر من مئة يوم. لكن المخيمات بدأت بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية في منتصف أبريل 2024، بعد فضّها بعنف في “جامعة كولومبيا” Columbia University. نصب آلاف الطلاب خيامهم داخل المباني وعبر الساحات والمساحات الخضراء في أكثر من 180 جامعة حول العالم. وعلى مدار أسابيع وأشهر، بنى الطلاب البنية التحتية اللازمة لاستمرارهم بينما كانوا يحشدون تضامناً مع حركة التحرير الفلسطينية. وانضم أعضاء هيئة التدريس والموظفون وأفراد المجتمع إلى التعبئة التي قادها الطلاب، مقوّضين بذلك التسلسلات الهرمية الجامعية التقليدية والحدود بين الحرم الجامعي والأحياء التي يندمجون فيها.
أصبحت المخيمات داخلياً تجارب في إعادة صياغة العالم. أو كما كُتب على لافتة رُفعت في اليوم الأول من مخيم “جامعة تورنتو” University of Toronto مقتبسة من المناضل والكاتب والسياسي الفرنسي من مارتينيك “إيمي سيزير” Aimé Césaire”الشيء الوحيد في العالم الذي يستحق البدء به… نهاية العالم بالطبع!”.
شيّد الطلاب ملاجئ وتشكيلات مكانية وتنظيمية جديدة، مُعيدين إنتاج بعضهم البعض ومُغذّين بعضهم البعض، مُبتكرين طرقاً مُختلفة لسكن الحرم الجامعي. استعانوا بنظريات مُناهضة الاستعمار، والماركسية، والفوضوية، والنسوية لتصميم حوكمة وصنع قرار أفقيين وخاضعين للمساءلة. بنوا مكتبات من كتب مُستبعدة من مجموعاتهم المؤسسية، وصمموا مناهج وبرامج تعليمية سياسية لتشمل النقد الفلسطيني المُحذوف من مناهجهم والذي غالباً ما يُعتبر خارج نطاق الخطاب الجامعي المُتعارف عليه.
وُجّهت حركات التعبئة الخارجية للمخيمات في المقام الأول نحو إدارات جامعاتهم، وتمحورت في أغلب الأحيان حول مطلبين أساسيين. الأول: أن تسحب مؤسساتهم استثماراتها من مُصنّعي الأسلحة وجميع الكيانات المُستفيدة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. والثاني: أن تقطع علاقاتها الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية المُتواطئة. استجابةً للدعوة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. واستجابةً للدعوة الفلسطينية عام 2005 لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وبناءً عليها، حشدت انتفاضة الطلاب ضد الإبادة الجماعية في غزة من خلال تعطيل تواطؤ جامعاتهم في حرمان الفلسطينيين من الحرية. لا سيما في جامعات أوروبا وأمريكا الشمالية، التي أشار إليها الفلسطينيون كممكّنات رئيسية للفصل العنصري الإسرائيلي من خلال تعاونها المؤسسي والمالي العميق مع نظام التعليم العالي الإسرائيلي.
علماء يهود أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية
“نعوم تشوموسكي” Noam Chomsky أستاذ جامعي أمريكي يهودي ومفكر وعالم، اشتهر بأعماله في اللغويات والنشاط السياسي والنقد الاجتماعي. يُلقب أحيانًا بـ “أبو اللغويات الحديثة”. يعتبر تشومسكي، المناهض للصهيونية، أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين أسوأ من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وينتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل.
“لاري هوشمان” Larry Hochman أستاذ الفيزياء اليهودي في جامعة ميشيغان، والمعروف بكتابه “الصهيونية والدولة الإسرائيلية” Zionism and the Israeli State عام 1967، والذي قال: “لقد أُقيمت دولة يهودية في قلب العالم العربي دون دعوة أو موافقة السكان الأصليين. ولا يمكن للهجرة اليهودية التي حدثت أن تتم إلا في ظل السيطرة الاستعمارية الغربية”.
“جيف هالبر” Jeff Halper عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي الإسرائيلي، الذي عاش في إسرائيل حتى عام 1973. عرّف نفسه بأنه يهودي إسرائيلي، واعتبر إسرائيل دولة “فصل عنصري”. وقف هالبر بقوة ضد احتلال الأراضي الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين. وكان أيضاً مديراً للجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل (ICAHD). وأشار إلى غزة بأنها “أكبر سجن في العالم”. وقال: “لقد طورت إسرائيل ما نسميه مصفوفة السيطرة، ويمكن تتبع تطور هذه السياسات بوضوح”. وذكر في بيان “لا يمكنكم تصوير أنفسكم كضحايا، بل أن تكونوا رابع أكبر قوة نووية في العالم”، وأضاف لاحقًا: “كيف يُمكنكم استيعاب حقيقة أننا أقوياء للغاية، لكننا ضحايا، ومع ذلك يجب عليكم دعمنا؟ إن هذه الرسالة المُختلطة هي ما يُمثل إشكالية لإسرائيل”.
“إيلان بابيه” Ilan Pappé مؤرخ وأكاديمي إسرائيلي يعيش في المملكة المتحدة، يُعرف بأبحاثه حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصة كتابه “التطهير العرقي لفلسطين” The Ethnic Cleansing of Palestine.
“نورمان فينكلشتاين” Norman Finkelstein أكاديمي وعالم سياسية يهودي أمريكي ومؤلف، كتب بغزارة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، متحدياً في كثير من الأحيان الروايات السائدة ومنتقداً السياسات الإسرائيلية.
“جوديث بتلر” Judith Butler فيلسوفة وعالمة اجتماع يهودية أمريكية بارزة ومُنظّرة في مجال الجندر، انخرطت في القضية الفلسطينية من خلال الكتابة الأكاديمية والنشاط، مُركّزة بشكل خاص على مفهوم “الهشاشة” وأهميته في حياة الفلسطينيين.