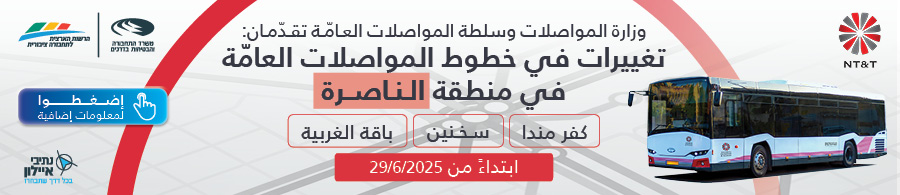“النهار بعد ألف ليل”، رواية للدكتور محمد هيبي!
خالدية أبو جبل
تاريخ النشر: 14/05/25 | 23:22
تقع الرواية في 525 صفحة من الحجم الوسط.
تصميم الغلاف د. محمد هيبي، فلسطين.
صادرة عن دار الشامل للنشر والتوزيع، نابلس، فلسطين.
المبدع الحقيقيّ عندما هو من يزرع زيتونًا لا شعيرًا، وينظر إلى الغد أكثر من حرصّه على اليوم، ويرى المستقبل في عيون الصغار أكثر. وهذا ما أراده د. محمد هيبي في روايته “النهار بعُد ألف ليل” بدءًا بالعنوان الذي جاء متضمنًا للعلامة والرمز وتكثيف للمعنى، بحيث يحاول أن يُثبت به قصدهُ برمّته، وهو عنوان اعتمد على الزمن، فـ “ألف” هي تعبير عن زمن سابق وحاضر مجهول غير محدّد، حتى لو ذُكر العدد ألف، فهو رمزٌ للكثير حسب ما راحت إليه المعتقدات الراسخة في الأذهان. وهو العدد الذي ذُكر في القرآن الكريم، “ألف سنة ممّا تعدّون”، آية 5 سورة السجدة. وهو العدد الذي عُرفت به قصص شهريار وشهرزاد، “ألف ليلة وليلة”، غير أنّ المؤلف اختار النهار ليلحق بالألف ليل، وهو أيضا الزمن اللاحق وغير المحدّد قدومه، لكنّه لا بدّ آتٍ. بدلالة أل التعريف. هذا ما آمن به المؤلّف وما أراد أن نؤمن بقدومه بيقين.
هكذا نجح المؤلّف أن يجعل عنوانه مثيرًا مختصرًا مُستجيبًا لرؤياه، قدّم إضاءة غير مباشرة لموضوع الرواية.
يؤمن المؤلّف أنّ السياسة موجودة ومؤثّرة في كلّ تفاصيل حياتنا، لكنّه لم يشأ لروايته أن تصبح مجرد تفاصيل سياسيّة، بل أراد لها أن تكون أساسًا ينطلق منه لبناء الوعي، من خلال روايةٍ عكست حياة الشعب الفلسطيني – على أرضه الفلسطينية داخل دولة إسرائيل – بكلّ ما فيها من مرارة وحلم وطموح ورغبة في التغيير. وهي التي تجعلنا نعرف في أيّ مستنقع نعيش الآن، وأيّة إرادة نملك لكي نغادره ونجعله جزءًا من مُخلّفات الماضي. فالرواية أو أيّ عملٍ أدبيّ من شأنه أن يُغيّر الإنسان لا يُغير الواقع، وهو ما يُعوّل عليه في تغيير الواقع. وبما أنّ “التاريخ ذاكرة إضافيّة للإنسان، تضطرُه لإعادة اكتشاف النار، لذلك من الضروري الإلمام بدروسه والتوقّف عند منعطفاته بشكلٍ خاصّ، لمعرفة كيف حصلت الأمور ولماذا أخذت هذه المسارات، أكثر ما يستوجب ذلك معرفة أسباب الهزائم والتراجعات””. . وفقَ هذه النظرية نرى أن المؤلّف آمن بأنّ كلّ ما عاشه أجدادنا وآباؤنا على مدى ما يزيد عن القرن وربع القرن إنّما هو نتاج مؤامرة كبيرة وعريضة كانت ولا زالت أقوى وأكبر من قدراتنا، ورأى أنّه عليه أن يُعيد قراءتها بشكل مختلف من خلال نظرة مختلفة وإعادة طرح الأسئلة من خلال تعدّد القراءات للحدث الواحد. أن نفهم بشكل مشترك الآليّة التي حكمت سير الأحداث، لتحديد الأسباب العميقة للإخفاق الذي تكرّر مرّات عديدة في تاريخنا ولا زال … فلا زال الدّم لون نهار الفلسطينيّ والدمع وسادة ليله.
توهِمُ البداية في “النهار بعد ألف ليل”، بما هو واقعي لاستقبال الأحداث والإيهام عن طريق اختفاء الراوي وراء حجاب سميك، وهو يقدّم المشهديّة الرومانسية لواقع مرئي يدفع بجذوره نحو اللامرئي. الصخرة، البحر، الغروب، إنّها رمزيّة النظرة الاستكشافيّة البعيدة والثبات. أعطاها المؤلف صفة شاعريّة تحوّلت في الرواية إلى رمز ذي صفة إيجابيّة لتعبّر عن التجربة الحسّيّة للإنسان. فتلك النظرة الحادّة الشاردة – والتي ورثها الحفيد عن الجد – نحو الغرب من على الصخرة الرابضة على الشاطئ، وكأنّ الحزن والغضب يقولان من خلالها: “ما بيجي من الغرب إشي يسُّر القلب”، فما جاء من الغرب إلّا الغرباء، ثمرة المؤامرة، شعب اسمه اليهود. وِفقَ هذه الرؤية فقد احتوت البداية على عناصر سرديّة هامّة رافقت الرواية من أولها إلى آخرها، وهي ما جعلت المتلقّي يتأكّد أنّ سارد البداية هو نفسه سارد الرواية، فجاءت على شكل خطاب شفوي ترمي إلى تبليغ معلومة مكثّفة، تقدّم العديد من المكوّنات التي ستتوسع تفاصيلها فيما بعد. وكأنّ الصباح غير العادي، صباحٌ استفاق فيه خالد الجوهريّ جدّ مصطفى، من غيبوبته الطويلة، صباحٌ يبحثُ فيه عن نفسه الدفينة، صباحٌ له أهميّته، فهو الزمن الذي ستجري فيه أحداث الرواية. فالمؤامرة وإن كانت تتمّ في الخفاء إلّا أن تطبيقها كان مُعلنًا في وضح النهار، بحضور العمى أو التعامي العربي، والمكر واللؤم الغربي. هذه العودة إلى الحياة بعد غيبوبة طويلة كانت أقرب و أشبه بالموت، فجّرت الزمان في ذاكرة خالد الجوهريّ ليعود إلى الماضي ويعيش في الحاضر، ليقدّم لنا وثيقة تاريخيّة على لسان شهرزاد – وهي شخصية وهميّة اختارها المؤلف لتسرد لنا أحداث رواية “نور الجليل” و”جوهرة الشرق” كناية عن فلسطين – عن طريق الاسترجاع. وأبدع المؤلّف في مزجه عالم الخيال بالواقع لتتداخل الأزمنة وتتواصل تواصلًا عميقًا يعيد سيرورة التاريخ. وقد نجحت الساردة في أن تجنح من حين لآخر إلى قنوات أخرى تُخلِّص الرواية من رتابة التاريخ باللجوء إلى المتخيّل والاجتماعي، فتصمت حينًا لنعاس، أو نشوة في أحضان خالد الجواهريّ. وحينًا آخر تشّد المتلقّي ليقتفي خطوات قصّة عشق خالد لـ “هدية”، وما تلاها من أزمات وتحوّلات وَلّدت إحساسًا مُتناميًا وشعورًا تجلّى في الألم واليُتم والقهر والكراهية. هذا الألم والغُبن الذي لحق بأبناء هذه الأرض، جعلَ المؤلف يستخدم وسيلة التّقطيع ليطّل بين حين وآخر صوت مصطفى الحفيد ليروي ما وصل إليه جيله في ظلّ هذا الواقع الأليم، وهو استجابة مباشرة “لما يعيشه الفلسطينيّ على المستوى الشعوريّ زمانين ومكانين، زمكان الماضي وزمكان الحاضر، فبينما يتسّم زمكان الماضي بالألفة والإيجابيّة، يتميّز زمكان الحاضر بالقلق والخوف واليأس والاستلاب الذاتي”. فقد كانت الجامعة هي المكان الجامع لشخصيّات تتناقض في تاريخها وايدولوجيّاتها وهي دلالات تصوّر واقع الأزمة في العلاقات بين الفلسطينيّين الذين يحملون الهويّة الإسرائيليّة، والإسرائيليّين، وأساس هذه الأزمة الصراع على الأرض – المكان، تمثّل هذا الصراع بين شخصيّة مصطفى المحاضر بموضوع الرواية والتاريخ في جامعة الكرمل، وشخصيّة عوفاديا المحاضر بموضوع التاريخ في الجامعة نفسها. فكيف للفلسطينيّ الذي لم يكن يومًا مُستأجرًا للبيت الذي يسكنه، بل هو بيت جُبل طينه من عرق الأجداد والآباء، كيف له أن يُسلّم أو يصمت إزاء تزييف التاريخ وتشويه الحقائق؟ كيف لمصطفى الذي رحل عنه والده شهيدا ولم يكّحل عيناه بمحياه أن ينسى، وإن سلّم لحكم الله في الموت والشهادة، فهل ينسى بيته وبيت أجداده؟ هل ينسى أرضًا ارتوت بعرق أبويه وأجداده ويُسلّم أنّ هذه الأرض من حقّ الغرباء(اليهود)؟ وهل فعلا صارت من حقّهم بفعل قرار آثم أرتُكّب في دهاليز مملكة الضباب، (بريطانيا)؟ هل ينسى أترابه وأصدقاءه في نور الجليل؟ أم هل يُسلّم أنّ جوهرة الشرق (فلسطين)، هي أرض شعب الله المختار؟ وإن تعامى عن كلّ هذا وأكثر، فهل يُكّذب نفسه وجدّه الذي لم يستفق من غيبوبته الطويلة إلّا ليكون شاهدًا على العصر، ليروي لنا قصة أولى السفن التي جاءت من الغرب تحمل الغرباء بثقل للتخلّص منهم على الشاطئ وتقفل راجعة لتتركهم يعيثون في الأرض فسادًا، وليروي لنا قصّة أول رصاصة وأول بندقية رُفعت للمقاومة، وأول شهيد لتتبعه قافلة شهداء، وأول قطعة أرض سُلبت على أيدي الغرباء، وليروي لنا حلقات مسلسل الإخفاقات والنكبات والنكسات والخيبات والخيانات على مستوى الأفراد والدول وليختم بأوسلو الخذلان.
هذا السلسال العجيب الغريب هو ما كوّن شخصيّة مصطفى وأبناء جيله، فجاءت شخصيّته جامعة حتى أصبحت تختصر سمّات شعبٍ ذاق الذّل والظلم، ينزِفُّ والعالم يتنافس على سبق صحافي لنشرات الأخبار.
ولو علمنا أنّ كاتب الرواية، د. محمد هيبي هو ابن قرية “ميعار” الجليليّة المهجّرة، والمقيم في قرية “كابول” التي لا تبعد عن ميعار، لعرفنا قسوة أن يصبح المرء لاجئًا في وطنه، ولعرفنا سرّ هذا التشبّث بالأرض والهوية، ومعنى أن تأتي الرواية حاملة لبعض سمات الإيقاع النفسيّ له، وكيف انطبعت بإيقاعه الاجتماعيّ والسياسيّ والفكريّ.
“النهار بعد ألف ليل” اقتربت بمسافتها الفنيّة من وجدان المتلقّي ومتخيّله ومن قضاياه الثابتة أو المتغيّرة والعابرة وارتباط كلّ ذلك بجسور مع الثقافيّ والتاريخيّ والاجتماعيّ والذاتيّ واللاشعوريّ ثم مع الفنيّ الجماليّ.
ملاحظة أولى: كثيرًا ما راودتني فكرة خلال القراءة، لو أنّ هذه الرواية تُكتب بأسلوب يناسب اليافعين وبصفحات أقلّ، ليُقبلوا على قراءة تاريخهم الصادق بعيدًا عن دجل وتزييف المناهج التدريسية.
ملاحظة ثانية: ولأنّ التّمزّق بلغ الذروة، ولأنّ التخيّل صار مستحيلا أمام ما نعيش ونرى، ولأنّ الموت صار نعمة ورحمة أمام الإبادة وحضور الصمت الرهيب، لأجل كلّ هذا وأكثر كانت قراءة الرواية تحت وطأة هذه الأجواء مؤلمة وموجعة … فالمؤامرة هي ذاتها المؤامرة والدّم هو ذاته الدّم. لكن سيكون نهار بعد ألف ليل، لا بدّ سيكون النهار.