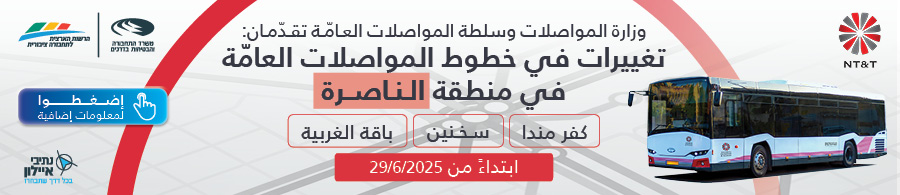الأدب الفلسطيني بين 1995 و2024: بين النزيف والنهوض
بقلم: رانية مرجية
تاريخ النشر: 01/07/25 | 13:28
من يقرأ الأدب الفلسطيني بين عامي 1995 و2024 لا يمكنه أن يفصل بين الحبر والدم، بين اللغة والهوية، بين القصيدة والمنفى، بين الرواية والجدار. إنه أدب كُتب تحت الخطر، ونُحت من الصمت والحرمان، وسُقي من خيبات السياسة ووجع المكان، لكنه أيضًا أدب النهوض، والمقاومة الثقافية، وتثبيت الوجود في وجه المحو.
أولاً: الأدب الفلسطيني بعد أوسلو – الحيرة والتمزق
اتفاق أوسلو في 1993 شكّل بداية مرحلة جديدة للأدب الفلسطيني، بدأت تتضح معالمها أكثر بعد 1995. مرحلة لا يمكن وصفها بالتحرر، بل بالتمزق والقلق الوجودي. لم يعد “العدو” خارجيًا فقط، بل بدأ الأدب يلتفت إلى الداخل: فساد السلطة، الانقسام، الصراع بين النخبة والشعب.
إبراهيم نصر الله، برواياته الملحمية مثل زمن الخيول البيضاء، لم يهادن أحدًا. صوّر القضية الفلسطينية كملحمة جمالية ووجودية.
سحر خليفة، في رواياتها خلال هذه الحقبة، أبرزت الجدل بين الأنثى والمجتمع الذكوري من جهة، وبين الفلسطيني والسلطة من جهة أخرى.
رشاد أبو شاور، ظل وفياً للغة الثورة والحنين إلى المخيم، ولكن بلغة أكثر وجعًا وقلقًا.
ثانياً: الجيل الجديد – الكتابة من داخل النار
في العقدين الأخيرين، ظهر جيل شاب لم يعش النكبة لكنه وُلد في ظلها، لم يذق المنفى بالمعنى الكلاسيكي، بل عاشه داخل “الوطن المجزّأ”. هذا الجيل أعاد تعريف فلسطين كهوية شخصية يومية لا مجرد شعار قومي.
مجدي دعيبس، كتب عن الفلسطيني الذي يعيش في مناطق الـ48، المحاصر بالهوية الإسرائيلية، بلغة سخرية سوداء.
غسان زقطان، الشاعر الذي هاجر كثيرًا، لكنه ظلّ يبحث عن “مكان بلا منفى”، لغته ضبابية لكنها مشحونة بكل ثقل الغياب.
ثالثاً: النسوية الفلسطينية – الصوت الذي كان خافتًا وصار عاصفة
لم تعد الكاتبة الفلسطينية مجرّد ظلّ لمأساة شعبها، بل صارت فاعلة نقدية داخل هذا الخطاب. برزت كتابات نقدية وجريئة عن الجسد، الدين، الزواج، التحرش، وأيضًا عن الاحتلال كقمع مضاعف.
ميسون أسدي، كاتبة قصصية تتناول واقع المرأة الفلسطينية في أراضي 48، بأسلوب جريء، يكشف ازدواجية القمع.
ربى بلال عسّاف، في نصوصها المسرحية، حوّلت المسرح إلى بيت وجدان فلسطيني، مليء بالأسئلة الجارحة عن الوجود والمرأة والوطن.
رابعاً: الشعر كنافذة خلاص
بين 1995 و2024، لم يخفت الشعر الفلسطيني، بل تطوّر ليصبح أكثر تجريبًا. انتقل من خطاب شعاراتي إلى لغة مشحونة بالأسى والبحث عن المعنى.
تميم البرغوثي، ربط بين الفصحى والمسرح الشعبي، وخلق جسراً بين التاريخ والواقع بلغة غنائية آسرة..
مراد السوداني، أعاد إلى القصيدة الفلسطينية هدوء النار، واشتغالها على الرمزية.
حنان جبيلي عابد، شاعرة من جيل جديد، تنسج قصائدها كمن تصلّي للهوية وللذاكرة، بشاعرية تخترقك كقذيفة ببطء.
خامساً: المنفى الرقمي – الكتابة على حافة فيسبوك
ما بين 2010 و2024، ظهر نمط جديد من الأدب الفلسطيني: كتابة فيسبوكية/رقمية تخلط بين الشعر والمقال، بين اللغة الكلاسيكية والمحكية، بين السياسي والوجداني. ومع الحرب على غزة، والهجمات على الضفة، صار “المنشور” سلاحًا ومتنفسًا ومرآة.
لكن أيضًا، كان هذا منبرًا لتفريغ الغضب، لا دوماً لإنتاج أدب خالد. ومع ذلك، نجد فيه جماليات جديدة، وجرأة على كسر الأنواع الأدبية التقليدية.
سادسًا: التحديات المستقبلية
رغم كل هذا التنوع، يبقى التحدي الأكبر هو: كيف يكتب الفلسطيني أدبه في ظل التطبيع الثقافي، ومصادرة الأرض، والتغييب الإعلامي؟
هل يكون الأدب أداة بقاء؟ أم مجرد توثيق للخسارات؟
هل نحتاج لأدب يحتفل بالفرح، لا فقط بالموت؟
هل يستطيع الجيل القادم أن يكتب فلسطين خارج الأسى؟ ربما، لكن دون أن ينسى أنه يكتبها من قلب الجرح.
خاتمة
الأدب الفلسطيني بين 1995 و2024 لم يعد حكرًا على المقاومة، لكنه لم ينفصل عنها. إنه أدب التناقضات، أدب الهُويات المشظّاة، أدب “اللاوطن” الذي يصرّ أن يكون وطنًا على الورق.
هو المرآة التي لم تنكسر، رغم أن الجدار تهشّم.
هو الصوت الذي لم يصمت، رغم أن الرصاص يصمّ.
هو فلسطين، حين لا نجدها، فيجدها الحرفُ فينا.